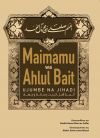العطلة الصيفية وفرص التطوير
الخطبة الأولى: العطلة الصيفية وفرص التطوير
جاء في وصية النبي لأبي ذرٍّ الغفاري: «يا أبا ذرّ، كن على عمرك أشحَّ منك على درهمك ودينارك»[1] .
لأبي ذرٍّ الغفاري: «يا أبا ذرّ، كن على عمرك أشحَّ منك على درهمك ودينارك»[1] .
ثمة أشياء في الحياة لا يمكن تعويضها إن فقدت، وأهمها عُمر الإنسان نفسه. فقد يفقد المرء بعض أو سائر ما يمتلكه من مال أو متاع، إلّا أنّ تعويض جميع ذلك يبقى أمرًا ممكنًا، فتلك طبيعة الأمور، خاصة في مجالات التجارة والأعمال. غير أنّ عمر الإنسان المتمثل في أيامه وساعاته في هذه الحياة، هي مما لا يمكن تعويضها إن فات شيء منها، ذلك أنّ رصيد الإنسان من الحياة محدود، فقد وضع الله سبحانه لكلِّ أحد، في «بنك الحياة» رصيدًا محدّدًا من العمر،﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [سورة النحل، الآية: 61] ويتضح جليًّا مدى قصر عمر الإنسان عند القياس مع حجم الطموحات والآمال الكبيرة التي يحملها، بسبب تميّزه بنعمة العقل، والروح التي بثّها الله ونفخ فيه من روحه. ومهما طال عمر الإنسان، الذي بلغت معدّلاته اليوم في بعض البلاد حدَّ الثمانين سنة، فإنّ ما يفقده من رصيد عمره المحدود، وأيامه المعدودة تلك، لن يتسنّى له تعويضها بأيِّ حالٍ من الأحوال، ما يعني ضرورة حرص الإنسان أشد ما يكون الحرص على كلّ لحظة من لحظات حياته.
استثمار كلّ لحظة حياة
وتضمّنت التعاليم الدينية الكثير من الوصايا في الدفع باتجاه استثمار أيام العمر وساعاته. ومن ذلك ما جاء في وصية رسول الله لأبي ذرٍّ الغفاري: «يا أبا ذرّ، كن على عمرك أشحّ منك على درهمك ودينارك»، فإذا كان المرء حريصًا على الحفاظ على مختلف أمواله من التلف والضياع، ويسعى بكلّ السُّبل نحو تنميتها، فإن الحرص ينبغي أن يكون مضاعفًا إزاء أيام عمره وساعات حياته.
لأبي ذرٍّ الغفاري: «يا أبا ذرّ، كن على عمرك أشحّ منك على درهمك ودينارك»، فإذا كان المرء حريصًا على الحفاظ على مختلف أمواله من التلف والضياع، ويسعى بكلّ السُّبل نحو تنميتها، فإن الحرص ينبغي أن يكون مضاعفًا إزاء أيام عمره وساعات حياته.
وجاء عن أمير المؤمنين أنه قال «إنّما أنت عدد أيام، فكلّ يوم يمضي عليك يمضي بعضك» [2] ، إنّ الإنسان كتلة من الزمن في هذه الحياة، وكلّما ذهب جزء من ذلك الزمن ذهب معه قسط من حياته، كما روي عنه
أنه قال «إنّما أنت عدد أيام، فكلّ يوم يمضي عليك يمضي بعضك» [2] ، إنّ الإنسان كتلة من الزمن في هذه الحياة، وكلّما ذهب جزء من ذلك الزمن ذهب معه قسط من حياته، كما روي عنه قوله: «ما أنقصت ساعة من دهرك إلّا بقطعة من عمرك»[3] ، وهذه كلمات رائعة ينبغي أن تلفت النظر إلى حقائق يغفل عنها الإنسان، مع كونها حقائق يعيشها عمليًّا.
قوله: «ما أنقصت ساعة من دهرك إلّا بقطعة من عمرك»[3] ، وهذه كلمات رائعة ينبغي أن تلفت النظر إلى حقائق يغفل عنها الإنسان، مع كونها حقائق يعيشها عمليًّا.
فائض الوقت في العطل
ضمن هذا السياق يمكن الحديث عن العطل الصيفية، واستثمار فائض الوقت فيها، فيما يعود بالنفع على الجميع. فالعطلات على نحو عام ومنها العطل الصيفية جاءت انعكاسًا لتطور قوانين العمل في العصور الحديثة، وقد بات للموظفين والطلاب بموجب ذلك حق التمتع بإجازات سنوية وعطل صيفية. من هنا يأتي السؤال عن الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها الناس مع هذه الإجازات والعطل، وما إذا كان يصلح التعامل معها باعتبارها إضافة غير محسوبة من العمر!؟ إذ إنّ هذا ما يبدو عليه تعامل بعض الناس مع إجازاتهم وعطلهم!، وتبعًا لذلك لا يبدون حريصين ولا مهتمين باستثمار هذا الوقت من حياتهم، وهذا خطأ كبير يقع فيه هذا الصنف من الناس. إنّ كلّ لحظة وساعة ويوم من عمر الإنسان هو قطعة من حياته، وإنّ عليه أن يستفيد منها وأنّ يستثمرها فيما ينفعه دنيا وآخرة.
ويهمّنا في هذه المساحة أن نتناول البرامج المخصصة لأبنائنا وبناتنا الطلاب خلال العطلة الصيفية، في بعدين أساسيين، يتعلق أحدهما بضرورة استثمار هذا الوقت، واستثمار طاقات أبنائنا خلاله، بحيث نحول العطلة الصيفية إلى فرصة للنمو والاستفادة النوعية، وجعلها قفزة تحقق المزيد من التقدم في حياة أبنائنا وبناتنا، عوضًا عن اعتبارها وقتًا ميّتًا، يجري قتله وإمضاؤه على أيِّ نحو كان. ومع التقدم الكبير الذي شهدته البشرية في العصر الراهن، فقد بات من الممكن الاستفادة على نحو أفضل من العطل الصيفية، خاصة في ظلّ وجود البرامج والوسائل والتسهيلات المتاحة في هذا السبيل.
العطل ومزالق الانحراف
أما البعد الآخر والأخطر فهو حماية الأبناء والبنات من الانزلاق خلال العطلة الصيفية إلى طريق الفساد والانحراف. ذلك أنه وبحسب الدراسات الاجتماعية الميدانية، ترتفع معدلات السلوكيات الطائشة والمنحرفة، في أوساط الشباب، خلال العطل الصيفية، والعامل الجوهري الذي يقف خلف ذلك هو زيادة أوقات الفراغ عند الشباب، التي لا يجري التعامل معها على نحو سليم. وقد ورد عن أمير المؤمنين قوله: «من الفراغ تكون الصبوة»[4] ، والمقصود بالصبوة هنا، هي الأعمال والممارسات الصبيانية الطائشة والمنحرفة، خاصة في ظلّ وجود من يستثمر هذا الفراغ عند الشباب لجرّهم نحو الانحرافات، وعلى رأس هؤلاء المستفيدين مافيا المخدّرات، والعصابات، والتجمعات الفاسدة، فالعطلة الصيفية عند هذه الفئات المنحرفة فرصة ثمينة لاصطياد الشباب والفتيات، وايقاعهم في بؤر الفساد والانحراف.
قوله: «من الفراغ تكون الصبوة»[4] ، والمقصود بالصبوة هنا، هي الأعمال والممارسات الصبيانية الطائشة والمنحرفة، خاصة في ظلّ وجود من يستثمر هذا الفراغ عند الشباب لجرّهم نحو الانحرافات، وعلى رأس هؤلاء المستفيدين مافيا المخدّرات، والعصابات، والتجمعات الفاسدة، فالعطلة الصيفية عند هذه الفئات المنحرفة فرصة ثمينة لاصطياد الشباب والفتيات، وايقاعهم في بؤر الفساد والانحراف.
البرامج الجاذبة الهادفة
وهنا يأتي الدور الحيوي للعائلات والمؤسسات الاجتماعية، والواعين في المجتمع، إزاء الاستفادة من العطلة الصيفية، في كسب الشباب نحو الاهتمامات المفيدة لهم ولمجتمعاتهم وأوطانهم. إنّ على كلّ عائلة أن تهتم بالتخطيط لاستثمار العطل في تنمية الأبناء، ومع بقاء الترفيه عنصرًا أساسيًّا، لكنه ليس كلّ شيء، فهناك برامج معروفة على مستوى العالم، وعلى مستوى المنطقة، ومن ذلك الرحلات المعرفية الصيفية، التي تتضمن إلى جانب الترفيه برامج معرفية وعلمية مفيدة، تطور من قدرات الأبناء والبنات، وتصقل مهاراتهم، وتطلعهم على آفاق جديدة مفيدة. وفضلّا عن ذلك، ينبغي على الصعيد المحلّي أن يجري تصميم البرامج المتنوعة التي تستوعب جلّ الأبناء والبنات خلال العطلة الصيفية.
ليس من الصّواب الاقتصار على نمطٍ واحد من البرامج الصيفية. فليس كلّ الأبناء متحمسين لدخول الدورات الدينية والثقافية، هناك من لديه ميول ومهارات فنية، وآخر تستهويه المجالات الرياضية، وثالث اهتماماته بيئية، وتبعًا لذلك ينبغي أن تخطط العوائل وأن تنشط المؤسسات الاجتماعية في هذا السبيل، وبإمكانها التخطيط لبرامج صيفية كثيرة، يتم من خلالها استقطاب القدرات والطاقات القادرة على إجراء الدراسات والأبحاث المفيدة، من الطلاب، والاساتذة الجامعيين، وأصحاب المهارات المختلفة، ولتصنع منهم فرقًا ناشطة في مجال البحث والدراسات الميدانية، حتى لو كان ذلك في مقابل مكافآت ومحفزات مختلفة، وهناك كثيرون ممن هم مستعدون لخدمة مجتمعهم متى ما رأوا في ذلك العمل والخدمة تطويرًا لكفاءتهم وقدراتهم. وعلى ذات المنوال ينبغي أن تجتهد الأندية الرياضية، والحال نفسه مع المساجد واللجان القرآنية، والمواكب الحسينية.
وفي هذا الصدد سبق لي الحديث مع عدد من مواكب العزاء حول ضرورة تطوير برامجها، وعدم الاقتصار على إقامة العزاء في أوقات المناسبات الدينية فقط، فالموكب الواحد من هذه المواكب قد يحتضن المئات من الشباب، وينبغي أن تقوم إدارة الموكب باستدعاء هؤلاء الشباب خلال العطلة الصيفية، وإفادتهم من خلال تقديم العديد من الدورات التثقيفية والمهارية، لتقوية قدراتهم وصقل مواهبهم، ويكفي لو حضر من شباب الموكب عشرة أو عشرون بالمئة، لأصبح عندنا عدد معقول من الشباب المنخرط في النشاط الصيفي للموكب.
ونلفت النظر أخيرًا إلى الاهتمام بوضع الفتيات، ذلك لأنّ البرامج الصيفية المخصصة للأولاد تُعَدّ أكثر نشاطًا في مجتمعنا، بخلاف البرامج المخصصة للفتيات، وربما يعود ذلك لمحدودية القدرة على الحركة بالنسبة للنساء إجمالًا، وهذا للأسف مدخل واسع لهدر الإمكانات والطاقات المجتمعية، فالمرأة كما الرجل تمامًا، طاقة كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات التنموية والمعرفية والاجتماعية المختلفة، ومن واجبنا جميعًا أن نوفّر لفتياتنا أجواء الخير والصلاح، حتى لا تستغلّ من قبل التوجّهات الفاسدة والمنحرفة.
كما ينبغي أن نوجه المزيد من الدعم المالي في خدمة الأنشطة الصيفية المخصصة لتنمية وتطوير أبنائنا وبناتنا، وذلك بنفس الحماس الذي نوليه لدعم إحياء المناسبات الدينية.
الخطبة الثانية: اصطناع المعروف لكلّ النّاس
جاء عن أمير المؤمنين : «ابذل معروفك للناس كافة، فإنّ فضيلة المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه شيء»[5] .
: «ابذل معروفك للناس كافة، فإنّ فضيلة المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه شيء»[5] .
ثمة تساؤل مطروح، عمّا إذا كانت سُبُل المساعدة وإسداء المعروف وتقديم الإحسان، ينبغي أن يكون مقتصرًا ومحصورًا ضمن دائرة المتوافقين عقديًّا وفكريًّا. فلا يعود عندها يشعر الإنسان بآلام أخيه الإنسان الآخر، ما لم يكن متوافقًا معه في العقيدة والدين، فضلًا عن الإحسان إليه؟
إنّ من المعروف أن الإنسان يُسرّ بوجود من يوافقه الرأي والعقيدة ضمن محيطه العام، لما في ذلك من تأكيد الثقة الذاتية، والرضا عن النفس وسلامة المسار، وهذا جانب من أسرار انجذاب الناس المتوافقين عقديًّا وفكريًّا لبعضهم بعضًا، كما أنّ هذه نزعة طبيعية عند الإنسان، قد تزداد أوارًا في ظروف التنافس والصراع الاجتماعي. وذلك ما ينصّ عليه القرآن الكريم؛ فالآية الكريمة ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ طبّقها القرآن الكريم على أصناف عديدة من الكفار والظالمين واليهود والنصارى، كما طبّقها على المؤمنين أيضًا، فقد جاء في الآية ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾. غير أنّ غياب التوافق الديني والفكري، هل يُعَدّ سببًا مقبولًا يمنع اصطناع المعروف مع الآخرين؟.
تحجيم النزعة الإنسانية
إنّ المتأمّل من زاوية وجدانية يجد أن لدى الإنسان نزعة أكثر اتّساعًا وهي النزعة الإنسانية. وجوهر تلك النزعة، ميل الإنسان إلى أخيه الإنسان، والتعاطف معه، ويعزّز الدين هذه النزعة الإنسانية، من خلال رفض اصطناع الحواجز العالية بين الإنسان وإخوانه من بني البشر، نتيجة اختلافهم معه في العقيدة.
إنّ من الصحيح أن للمتوافقين مع الإنسان في الدين حقًّا أوفر عليه، لكن هذا لا يعني بأيِّ حالٍ إسقاط حقوق الآخرين من المختلفين دينيًّا، ولا يعني الإجحاف والجفاء إزاءهم. ومؤسف أنّ بعض المتدينين وقعوا في سوء الفهم حين اعتقدوا أنهم ملزمون حصرًا بمساندة أبناء جماعتهم وأهل ملّتهم، وتأسّست في هذا السبيل مؤسّسات وجمعيات تعاونية وإغاثية، لكن خدماتها بقيت مقتصرة على المستحقين من لون ديني واحد، فيما نأت تمامًا عن تقديم الإغاثة والعون للمستحقين من غير المسلمين. ثم انسحبت التصنيفات الدينية في هذه المؤسسات على الداخل الإسلامي، فصارت تحصر مساعداتها في أتباع أهل مذهب دون أتباع المذاهب الأخرى. وفي هذا تحجيم بالغ لنزعة الخير ومشاعر النّبل الموجودة في أعماق الإنسان.
والأسوأ هو اعتقاد بعض المتديّنين: أن من صميم واجبهم الديني، أن يكونوا عدوانيين تجاه من يخالفهم في الدين أو المذهب. وهذا ظلم وانحراف واضح، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم ولا الاعتداء على الآخرين.
لا حواجز في عمل الخير
إنّ النصوص الدينية، تؤكّد بما لا يقبل الشك، على أنّ عمل الخير والإحسان إلى الناس، لا ينبغي أن يحدّده دين، أو مذهب، أو انتماء، وإنما ينبغي أن يكون منفتحًا على أبناء الإنسانية جمعاء.
وقد وردت نصوص دينية كثيرة تحضّ على بذل المعروف لكافّة الناس دونما تمييز. فقد جاء في الحديث عن النبي : «الخلق كلّهم عيال الله فأحبّهم إلى الله عزّ وجلّ أنفعهم لعياله» [6] ، وقد تحدث النبي الأكرم عن الخلق أجمعين ولم يحصر حديثه في المسلمين وحدهم.
: «الخلق كلّهم عيال الله فأحبّهم إلى الله عزّ وجلّ أنفعهم لعياله» [6] ، وقد تحدث النبي الأكرم عن الخلق أجمعين ولم يحصر حديثه في المسلمين وحدهم.
كما ورد عن الإمام الصادق أنه سُئل جدّه
أنه سُئل جدّه «: من أحبّ الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس»[7] ، ولم يقلّ أنفعهم للمسلمين.
«: من أحبّ الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس»[7] ، ولم يقلّ أنفعهم للمسلمين.
وأكثر من ذلك، فقد جاءت نصوص صريحة تدفع باتجاه الإحسان لغير المسلمين، كما ورد في قوله تعالى: ﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [سورة الممتحنة، الآية: 8]، وقد تضمنت الآية الكريمة وصايا صريحة بالبر والقسط مع غير المسلمين.كما ورد عن أمير المؤمنين أنه قال: «ابذل معروفك للناس كافة فإنّ فضيلة فعل المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه شيء» فبذل المعروف ينبغي أن يكون موجّهًا «للناس كافة».
أنه قال: «ابذل معروفك للناس كافة فإنّ فضيلة فعل المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه شيء» فبذل المعروف ينبغي أن يكون موجّهًا «للناس كافة».
ونجد النبي الأكرم يوصي على نحو صريح باصطناع الخير حتى لمن يُصنّفون فجّارًا ومنحرفين. فقد روي عنه
يوصي على نحو صريح باصطناع الخير حتى لمن يُصنّفون فجّارًا ومنحرفين. فقد روي عنه أنه قال: «رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس واصطناع الخير إلى كلّ برٍّ وفاجر»[8] ، ولعلّ في ذلك ردًّا على من يريد حرمان بعض المستحقين لمجرد انحرافهم الديني، وما يدريك، لعلّ في اصطناع الخير إعانة لذلك المنحرف على الاهتداء للطريق الصحيح.
أنه قال: «رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس واصطناع الخير إلى كلّ برٍّ وفاجر»[8] ، ولعلّ في ذلك ردًّا على من يريد حرمان بعض المستحقين لمجرد انحرافهم الديني، وما يدريك، لعلّ في اصطناع الخير إعانة لذلك المنحرف على الاهتداء للطريق الصحيح.
وهناك قصة متداولة قيل أن مجوسيًا استضاف إبراهيم الخليل فقال: إن أسلمت أضفتك، فمرّ المجوسي فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم تطعمه إلّا بتغيير دينه، ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره، فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك، فمرّ إبراهيم يسعى خلف المجوسي، فردّه وأضافه فقال له المجوسي: ما السبب فيما بدا لك؟ فذكر له، فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني ثم قال: أعرض على الإسلام، فأسلم[9] . فكانت كلمات إبراهيم هذه مفتاحًا لدخول الرجل في الإيمان وتركه الكفر.
فقال: إن أسلمت أضفتك، فمرّ المجوسي فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم تطعمه إلّا بتغيير دينه، ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره، فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك، فمرّ إبراهيم يسعى خلف المجوسي، فردّه وأضافه فقال له المجوسي: ما السبب فيما بدا لك؟ فذكر له، فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني ثم قال: أعرض على الإسلام، فأسلم[9] . فكانت كلمات إبراهيم هذه مفتاحًا لدخول الرجل في الإيمان وتركه الكفر.
أولويات لا تمنع التوسع
ليس من منطق الإسلام وضع حدود دينية أو قومية على فعل الخير للناس. إنّ من الصحيح إعطاء الأولوية للأرحام على قاعدة «الأقربون أولى بالمعروف»، لكن ذلك لا يعني الاقتصار عليهم، واحتكار عمل الخير فيهم وحدهم، ورد في رواية عن الإمام موسى الكاظم أنه قال: «أخذ أبي بيدي ثم قال يا بني، إنّ أبي محمد أخذ بيدي كما أخذت بيدك، وقال إنّ أبي علي بن الحسين أخذ بيدي، وقال: يا بني افعل الخير إلى كلّ من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله»[10] .
أنه قال: «أخذ أبي بيدي ثم قال يا بني، إنّ أبي محمد أخذ بيدي كما أخذت بيدك، وقال إنّ أبي علي بن الحسين أخذ بيدي، وقال: يا بني افعل الخير إلى كلّ من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله»[10] .
وروى معلّى بن خنيس أنّ الإمام الصادق خرج ومعه جراب من خبز، فأتينا ظلة بني ساعدة، إذا نحن بقوم نيام، فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين تحت وسادة كلّ واحد منهم، حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا، فقلت؛ جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة ـ وقيل الدقة أي الملح ـ»[11] ، وفي ذلك إشارة من الإمام
خرج ومعه جراب من خبز، فأتينا ظلة بني ساعدة، إذا نحن بقوم نيام، فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين تحت وسادة كلّ واحد منهم، حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا، فقلت؛ جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة ـ وقيل الدقة أي الملح ـ»[11] ، وفي ذلك إشارة من الإمام أنّ المطلوب إسداء الخير والمعروف لجميع الناس، سواء عرفوا الحقّ أم لم يعرفوه، آمنوا بديننا ومذهبنا أم لم يؤمنوا. إنّ من المؤسف جدًّا انكفاء عمل الخير في أوساط المسلمين واقتصاره على حدود جماعتهم، في حين نجد كيف تقوم المجتمعات الأخرى بأعمال الخير والبر بشكل مفتوح، وعلى مستوى الكرة الأرضية برمّتها.
أنّ المطلوب إسداء الخير والمعروف لجميع الناس، سواء عرفوا الحقّ أم لم يعرفوه، آمنوا بديننا ومذهبنا أم لم يؤمنوا. إنّ من المؤسف جدًّا انكفاء عمل الخير في أوساط المسلمين واقتصاره على حدود جماعتهم، في حين نجد كيف تقوم المجتمعات الأخرى بأعمال الخير والبر بشكل مفتوح، وعلى مستوى الكرة الأرضية برمّتها.
الاهتمام بالعمالة الأجنبية
من هنا ينبغي أن نكون أكثر التزامًا بتعاليم ديننا إزاء بذل المعروف للجميع. سيما وأن بلادنا تعجّ بالعمالة الأجنبية، وسواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فهم جميعًا بشر مثلنا، من الواجب أن نعطف عليهم، وأن نحسن إليهم، ولو بإيصال الماء البارد لهم، سيّما أولئك العاملون في أجواء مفتوحة في حرّ الصيف، وتحت أشعة الشمس الحارقة، فضلًا عن تهيئة السكن اللائق لهم، ذلك أنّ هؤلاء العمال يعيشون في كثير من الأحيان في ظروف مزرية. إنّ علينا أن نهتم بهؤلاء كما نهتم بأبناء مجتمعنا، فهؤلاء بشر، وسيسألنا الله تعالى يوم القيامة عنهم، فقد روي عن النبي قوله: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»[12] ، وقد تحدث النبي هنا عن الجار دونما تحديد أو اشتراط في أن يكون مسلمًا أو غير مسلم.
قوله: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»[12] ، وقد تحدث النبي هنا عن الجار دونما تحديد أو اشتراط في أن يكون مسلمًا أو غير مسلم.
إنّ من المعيب جدًّا في مجتمعاتنا النظر للآخرين نظرة ازدراء وتعالٍ لمجرّد كونهم عمّالًا أجانب فقراء. أوليس هؤلاء هم من يساعدونا في بناء بلادنا، ولولاهم من يا ترى سيكنس شوارعنا ومن يبني بيوتنا؟ وقد رأينا عندما وضعت بعض القيود على تأشيرات العمل لأمثال هؤلاء، كيف ضجّ المقاولون الراغبون في استقدام المزيد من العمال، وكذلك الحال مع أرباب الأسر الراغبين في استقدام سائقين وخدم لبيوتهم، أليس في ذلك دليلٌ على أنّ هؤلاء يقومون بدور كبير في حياتنا؟ من هنا فإنّ علينا أن نوسّع من أفقنا وأن نحسن لهؤلاء العمال، ونأمل قيام جمعيات خيرية تعنى بتحسين ظروف حياة العمالة الوافدة، وتهتم بتوفر العلاج الصحي لهم، وتحسين ظروف سكنهم ومعيشتهم، فهذا مما يأمرنا به الدين؛ لأنّ البرّ بالناس من أوليات الدين.