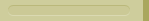حوار قناة حيرة (218)
حسن الصفار: فلسفة التعارف والحوار في الإسلام.. الهداية والجذب

أُجري الحوار في مكتب سماحة الشيخ حسن الصفار بالقطيف شرقي السعودية، بتاريخ 22 ذو الحجة 1445هـ الموافق ٢9 يونيو ٢٠٢٤م، وبُث بتاريخ 15 ذو الحجة 1446هـ الموافق 11 يونية 2025م، واستمر اللقاء أكثر من سبعين دقيقة.
أجرى الحوار لقناة حيرة[1] الأستاذ هادي محمد اللواتي[2] .
المحاور:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحّب بكم في سلسلة حوارات فكرية ومعرفية على قناة "حيرة"، من المملكة العربية السعودية، ومن المنطقة الشرقية تحديدًا، محافظة القطيف.
نتشرّف اليوم باستضافة سماحة الأستاذ الشيخ حسن الصفار، في هذا اللقاء الذي يتم في منزله العامر، أو بالأحرى في هذه المؤسسة التي يرعاها، وتضم مكتبة واسعة، ومتحفًا يحتوي على آثار وهدايا مرتبطة بمسيرته المباركة.
سماحة الشيخ حسن الصفار مفكر إسلامي بارز، وباحث جاد، اشتغل في مجالات متعددة، وله مؤلفات رصينة، منها: (التعددية والحرية في الإسلام)، (الحوار والانفتاح على الآخر)، (العقلانية والتسامح.. نقد جذور تطرف الدين)، (الإنسان قيمة عُليا)، (يقظة الروح)، (شخصية المرأة)، وغيرها من الكتب التي تعبّر عن فكره وتأملاته.
السلام عليكم سماحة الشيخ، وشكرًا جزيلًا لكم على هذه الفرصة الطيبة.
الشيخ الصفار:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شرفتمونا بزيارتكم، وأنا كنت من المتابعين لعدد من حلقات هذا البرنامج القيم.
وأُشيد بهذا التوجه المنفتح، الذي يسعى للحوار مع مفكرين من مختلف الأديان والمذاهب والمدارس الفكرية، من شتى البلدان. نحن بأمس الحاجة إلى هذا الأفق الواسع من الانفتاح والاحتضان، فبارك الله في جهودكم ودوركم النبيل.
المحاور:
بارك الله فيكم شيخنا العزيز.
اسمحوا لي أن لا أبدأ بالسيرة الذاتية كما جرت العادة، بل أنطلق من المحور الفكري الذي يشغل بالكم ويعبّر عن مسيرتكم الاجتماعية والفكرية:
محور التسامح، واحترام الآخر، والحوار، والتعددية، ومد اليد نحو المختلف.قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
متى كانت الشرارة الأولى لهذا التوجّه في مسيرتكم؟
هل جاء نتيجة تجربة حياتية متراكمة نضجت مع الأيام؟
وكيف نُؤصّل هذه الفكرة من الإسلام والقرآن الكريم وأحاديث النبي وأهل بيته
؟
إذ قد يرى بعض العلماء والمفكرين دلالات مختلفة في النصوص، فكيف تتعاملون مع هذه التعددية في الرؤية، خاصة في ظل الخطاب القرآني الذي قد يستند إليه أطراف مختلفة لرؤى متباينة في موضوع التسامح والانفتاح؟
الشيخ الصفار:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
انطلقتُ في هذا التوجّه من وحي معاناة شعرت بها منذ الصغر.
نشأت في مجتمع متدين محافظ، وهذا مما أحمد الله عليه، لكنني لاحظت أن هذا المجتمع محاط بعدد من الأسوار والحواجز.
كنا ندرس ضمن النظام الأكاديمي الرسمي في المملكة، وكنت ألحظ أن المناهج الدينية تركز بشكل كبير على الفواصل بيننا وبين "الآخر"، وتُغفل الحديث عن المشتركات الإنسانية والدينية.
أتذكّر أن مدرس اللغة الإنجليزية في المرحلة المتوسطة كان مسيحيًا، وكان تعامله معنا كطلاب أفضل من كثير من المدرسين المسلمين، من حيث الاحترام والرقي في الأسلوب.
كنت أُقارن بين ما تعلّمناه في المنهج الديني عنه كـ"كافر" وبين ما رأيته منه كإنسان، فبدأت تتكوّن لديّ تساؤلات عن مبررات هذا التباعد.
كذلك، نحن نعيش في بلد تتنوع فيه المذاهب، وأنا أنتمي إلى الطائفة الشيعية في محافظة القطيف.
لاحظت أن هناك انغلاقًا في مجتمعنا تجاه أتباع المذاهب الأخرى، كما كانت هناك أصوات متشددة ومتطرفة من الطرف الآخر تجاهنا.
شعرت أن هناك "سورًا" يحاصرنا كمسلمين تجاه غير المسلمين، وسورًا آخر داخل المسلمين بين الطوائف، بل حتى داخل الشيعة أنفسهم هناك أسوار بين المدارس المختلفة: الأخبارية، الأصولية، الشيخية.
بل حتى في داخل المدرسة الواحدة، نشأت أسوار جديدة: هذا يُقلّد مرجعًا، وذاك مرجعًا آخر، وتبدأ الخلافات والقطيعة حتى بين أبناء الأسرة الواحدة.
عاصرتُ حالات رفض للزواج بين عائلتين بسبب اختلاف المرجع، وهذا كان صادمًا لي.
كل هذه الأسوار جعلتني أتساءل:
لماذا نسجن أنفسنا داخل هذه الحواجز؟
لماذا أُعبّأ ضد إنسان لمجرد انتمائه الديني أو المرجعي؟
كل هذا دفعني للتفكير العميق، ودراسة الفكر الديني حول موضوع الحوار والانفتاح، وأنتجت لاحقًا كتبًا ومحاضرات في هذا السياق.
المحاور:
جميل جدًا يا شيخ.
وكما يُقال: السياق مهم لفهم المفكر.
في كتاب بنية الثورات العلمية لتوماس كون، نجد التأكيد على أهمية فهم السياقات الاجتماعية والزمانية لفهم أفكار المفكرين.
من الرائع أنكم شرحتم منطلق هذا التوجه، وهو في أصله اجتماعي معيشي، قبل أن يكون فكريًا.
لكن أريد أن أتناول نقطة مهمة:
كثير من هذه الأسوار تنطلق من مشاعر سلبية: الحقد، الكره، الغضب، ثم يُلبسها البعض لباسًا دينيًا وفكريًا.
ما رأيكم في هذا الاستخدام "المؤدلج" للنصوص؟
وكيف يمكنكم تأصيل فكر التسامح والحوار قرآنيًا، في ظل وجود آيات قرآنية تتحدث عن لعن الكافرين أو الظالمين أو المجرمين؟
كيف نفهم هذا التعدد الظاهري في الخطاب القرآني تجاه الآخر؟
الشيخ الصفار:
كما تفضلتم، هناك رواية عن الإمام عليه السلام تقول: "القرآن حمّال ذو وجوه".
بمعنى أن النص القرآني يمكن أن يُفهم بأوجه متعددة، وكل جهة قد تجد فيه ما يدعم رؤيتها.
وهنا يأتي دور العقل.
فالقرآن ليس خطابًا فوق العقل، بل هو خطاب موجه للإنسان العاقل.
ورد في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا  حين سُئل: مَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمَ؟
حين سُئل: مَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمَ؟
قَالَ  : «الْعَقْلُ؛ يَعْرِفُ بِهِ الصَّادِقَ عَلَى اللهِ فَيُصَدِّقُهُ، وَالْكَاذِبَ عَلَى اللهِ فَيُكَذِّبُهُ»[3] .
: «الْعَقْلُ؛ يَعْرِفُ بِهِ الصَّادِقَ عَلَى اللهِ فَيُصَدِّقُهُ، وَالْكَاذِبَ عَلَى اللهِ فَيُكَذِّبُهُ»[3] .
نحن حين نقرأ القرآن لا بد أن نستحضر عقولنا وضمائرنا.
الآيات التي تتحدث عن الكفار، غالبًا ما تأتي في سياق الصراع والعدوان.
أما من لم يُعادِ المسلمين ولم يُقاتلهم، فقد نهى الله عن الظلم في التعامل معه، بل أمر بالبر والقسط تجاهه، يقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾[ سورة الممتحنة، الآية: 8]
فلا يصح الاستشهاد بآيات نزلت في ظروف العدوان لتبرير كراهية دائمة، فهذه السياقات تختلف.
مثلاً قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾[سورة المائدة، الآية: 82] هذه الآية كانت تصف واقعًا معينًا، لكنها ليست قانونًا دائمًا.
اليهود في بداية الدعوة كانوا من أشد الناس عداوة، لكنهم لاحقًا لجأوا إلى بلاد المسلمين وعوملوا بإنصاف.
وكذلك النصارى، كانوا في زمن معين أقرب الناس مودة، لكن في الحروب الصليبية تغيّر السياق.
لذا فهذه النصوص لا تصلح أن تكون قاعدة تعميمية ضد الآخر، بل يجب فهمها في سياقها الزمني والاجتماعي.
المحاور:
جميل جدًا سماحة الشيخ.
دعونا نتعمّق أكثر في القرآن الكريم، ونحاول أن نستلهم منه الدعوة إلى الحوار، وإلى التعارف، وإلى البحث عن مواطن الجمال والخير والفضيلة في الآخر؛ سواء كان هذا الآخر مختلفًا في الدين، أو المذهب، أو الحضارة... كيف يمكن أن نرى هذه الدعوة القرآنية؟
الشيخ الصفار:
من القواعد المهمّة التي نجدها في القرآن الكريم: قاعدة الكرامة الإنسانية.
يقول تعالى:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾[سورة الإسراء، الآية: 70]
هذه الآية تُقرّر بوضوح أن تكريم الإنسان لا يقتصر على المنتمي لدين معين أو مذهب معين، بل يشمل بني آدم جميعًا، بمختلف أعراقهم وأديانهم وهوياتهم.
وقد أجمع كثير من المفسرين على أن هناك كرامة فطرية تُمنح للإنسان باعتباره إنسانًا، وهي غير مشروطة بدين أو عمل.
ثم تأتي مرتبة أرقى من الكرامة، وهي كرامة التقوى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[سورة الحجرات، الآية: 13]
فالأساس الأول أن الآخر المختلف دينيًا أو مذهبيًا يجب أن يُرى أولًا كإنسان كرّمه الله، وله مكانة عنده، وسخّر له من النعم ما يدل على تميّزه.
وقد جاء في الحديث الشريف: «الْخَلْقُ عِيَالُ الله، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى الله مَنْ نَفَعَ عِيَالَ الله»[4] .
وهذه القاعدة تدعونا إلى احترام الآخر والتعامل معه وفق هذا المفهوم، لا أن نُقصيه أو نُحقّره.
أيضًا، يجب أن نستحضر آيات المحكمات لتكون حاكمة على الآيات المتشابهات، كما ورد في القرآن: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾[سورة آل عمران، الآية: 7]
فالآيات المحكمة، المنسجمة مع العقل والضمير الإنساني، هي التي يجب أن نرجع إليها لتفسير المعاني الأكثر إشكالاً أو التباساً.
المحاور:
إذن، القرآن يمنح الإنسان كرامةً وقيمةً ومكانة.
لكن ما هي مقتضيات هذه الكرامة؟
كيف نتفاعل معها عند التعامل مع الآخر المختلف في الفكر أو الدين؟
وكيف نُدرك أن كثيرًا من مشاعر الكراهية أو الرفض التي نحملها ليست إلا نتيجة تربية لاواعية نُشأنا عليها؟
الشيخ الصفار:
هذا التساؤل مهم جدًا.
كثيرًا ما نتربى على رؤية الآخر المختلف على أنه ضال، فاسد العقيدة، منحرف المعتقد، يعبد ما لا يستحق العبادة...
وهذا المعنى يتسلل إلى لا وعينا من خلال آيات، مثل قوله تعالى:
﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾[سورة المائدة، الآية: 73]
وقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾[سورة مريم، الآيتان: 90-91]
لكن في الواقع، يجب أن ننظر للإنسان الآخر من خلال ظرفه الاجتماعي.
نحن أنفسنا نؤمن بما نؤمن به غالبًا، لأننا وُلدنا في بيئة دينية معيّنة، ونشأنا في عائلة متدينة بهذا الدين، وليس لأننا فكرنا واختبرنا الأديان جميعًا ثم اخترنا الإسلام.
وكذلك الطرف الآخر، هو لم يختر معتقده عنادًا أو كفرًا متعمدًا، بل نشأ في بيئة تقوده إلى ما يؤمن به الآن.
لا يصح أن نعتبره معاندًا من اللحظة الأولى، بل من واجبنا أن نتفهمه، ونحاول إيصال الحق إليه بالحكمة والموعظة، وبالقدوة الحسنة.
تعاملنا الإنساني الراقي معه، قد يكون له أثر بالغ في انفتاحه على الحق.
القرآن يفرّق بين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[سورة الإسراء، الآية: 15]
وفي علم الأصول لدينا قاعدة: قبح العقاب بلا بيان. لذا، لا يجوز لنا الحكم على الآخر بأنه كافر معاند دون أن نتبيّن حاله وظروفه.
علينا أن نحسن الظن، ونُفرّق بين الفكرة الخاطئة التي نرفضها، وبين الإنسان الذي يحملها، والذي يجب احترامه ما لم يتضح لنا العكس.
المحاور:
رؤية رائعة.
دعونا ننتقل إلى تراث أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وأنتم لكم كتابات متعددة في هذا المجال.
ما الذي نجده في رواياتهم من توجيه في التعامل مع الآخر؟
هل هناك كنوز مغفول عنها؟
الشيخ الصفار:
بالتأكيد، في تراث أئمة أهل البيت  ، نجد ثروة عظيمة من الروايات التي تدعو للتسامح، والانفتاح، وكسب القلوب. مثلًا، ما ورد عن الإمام الحسن العسكري
، نجد ثروة عظيمة من الروايات التي تدعو للتسامح، والانفتاح، وكسب القلوب. مثلًا، ما ورد عن الإمام الحسن العسكري  : «كُونُوا زَيْناً وَلاَ تَكُونُوا شَيْناً، جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ، وَاِدْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ»[5] ، وعن الإمام علي بن موسى الرضا
: «كُونُوا زَيْناً وَلاَ تَكُونُوا شَيْناً، جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ، وَاِدْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ»[5] ، وعن الإمام علي بن موسى الرضا  : «إِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لَاتَّبَعونا»[6] ، وعن الإمام جعفر الصادق
: «إِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لَاتَّبَعونا»[6] ، وعن الإمام جعفر الصادق  : «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ، وَصَدَقَ الْحَدِيثَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ، قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ»[7] .
: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ، وَصَدَقَ الْحَدِيثَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ، قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ»[7] .
حتى على مستوى العلاقة بالمخالف في المذهب، نجد في الروايات، كما عن الإمام جعفر الصادق  : «صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ، وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُم»[8] ، فهي دعوة واضحة للاندماج لا للانعزال، وللأخلاق لا للمواجهة.
: «صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ، وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُم»[8] ، فهي دعوة واضحة للاندماج لا للانعزال، وللأخلاق لا للمواجهة.
بل إن أئمة أهل البيت  وجّهوا أصحابهم إلى الكفّ عن الناس، وضبط اللسان، والخلق العالي، والتسامح الإنساني. الإمام علي
وجّهوا أصحابهم إلى الكفّ عن الناس، وضبط اللسان، والخلق العالي، والتسامح الإنساني. الإمام علي  يقول فيما يروى عنه: «إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ، فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ، ومَحَامِدِ الأَفْعَالِ، ومَحَاسِنِ الأُمُورِ»[9] .
يقول فيما يروى عنه: «إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ، فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ، ومَحَامِدِ الأَفْعَالِ، ومَحَاسِنِ الأُمُورِ»[9] .
المحاور:
هذا التراث الإنساني من أئمة أهل البيت
يبدو وكأنه غُيّب عن كثير من منابرنا وخطاباتنا. هل ترى أن ذلك حجب عنا رؤيةً جوهرية في تعاملنا مع الآخر؟
الشيخ الصفار:
نعم، بكل وضوح. للأسف، كثير من خطاباتنا الدينية تنطلق من ردّات فعل، من مواقف معيشة يعيشها الخطيب أو الداعية، فتتغذى على التعبئة والمواجهة بدلًا من تقديم النموذج القرآني والعلوي.
النهج العام لأئمة أهل البيت  هو نهج القرآن: الدعوة إلى التسامح، إلى التعايش، إلى الاندماج، لا إلى التحصّن والانغلاق.
هو نهج القرآن: الدعوة إلى التسامح، إلى التعايش، إلى الاندماج، لا إلى التحصّن والانغلاق.
لدينا روايات كثيرة عن أمير المؤمنين  في تعامله مع غير المسلمين، تُذكر ويفرح بها المستمع، لكنه لا يستلهم منها نموذجًا يُطبّقه في حياته.
في تعامله مع غير المسلمين، تُذكر ويفرح بها المستمع، لكنه لا يستلهم منها نموذجًا يُطبّقه في حياته.
مثال ذلك: قوله  : «وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا[10] وَقُلُبَهَا[11] وَقَلَائِدَهَا وَرُعُثَهَا[12] ، مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ، مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً، مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً»[13] ، وذلك في استنكاره لانتهاك حرمة غير المسلم، تمامًا كانتهاك حرمة المسلم.
: «وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا[10] وَقُلُبَهَا[11] وَقَلَائِدَهَا وَرُعُثَهَا[12] ، مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ، مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً، مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً»[13] ، وذلك في استنكاره لانتهاك حرمة غير المسلم، تمامًا كانتهاك حرمة المسلم.
أيضًا: رواية مشهورة عن الإمام علي  ، وهو يُشيّع رجلًا غير مسلم صحبة في الطريق، ويمشي معه مسافة عند مفترق طريقهما رغم اختلاف الدين، دون أن يدخل معه في مناظرة، أو أن ينظر إليه باحتقار[14] .
، وهو يُشيّع رجلًا غير مسلم صحبة في الطريق، ويمشي معه مسافة عند مفترق طريقهما رغم اختلاف الدين، دون أن يدخل معه في مناظرة، أو أن ينظر إليه باحتقار[14] .
كذلك، في سيرة الإمام الرضا  ، حين حضر مجلس المأمون العباسي وناظر علماء الأديان، كان يتحاور معهم بكل احترام، دون تجريح، ودون استعلاء.
، حين حضر مجلس المأمون العباسي وناظر علماء الأديان، كان يتحاور معهم بكل احترام، دون تجريح، ودون استعلاء.
تحاور معهم كما يتحاور مع أي إنسان يُقدّر رأيه، حتى لو خالفه.
للأسف، الكثير من الروايات التي تُستخدم للتشدد اليوم هي روايات موضوعة، وضعها المغالون والمتطرفون لإثارة العداء، ولصناعة حاجز نفسي بين أتباع أهل البيت وبين غيرهم.
بل لدينا رواية صحيحة السند عن الإمام الرضا  تقول: «إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا وَ جَعَلُوهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا اَلْغُلُوُّ وَ ثَانِيهَا اَلتَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا وَ ثَالِثُهَا اَلتَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا فَإِذَا سَمِعَ اَلنَّاسُ اَلْغُلُوَّ فِينَا كَفَّرُوا شِيعَتَنَا وَ نَسَبُوهُمْ إِلَى اَلْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا وَ إِذَا سَمِعُوا اَلتَّقْصِيرَ اِعْتَقَدُوهُ فِينَا وَ إِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا»[15] .
تقول: «إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا وَ جَعَلُوهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا اَلْغُلُوُّ وَ ثَانِيهَا اَلتَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا وَ ثَالِثُهَا اَلتَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا فَإِذَا سَمِعَ اَلنَّاسُ اَلْغُلُوَّ فِينَا كَفَّرُوا شِيعَتَنَا وَ نَسَبُوهُمْ إِلَى اَلْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا وَ إِذَا سَمِعُوا اَلتَّقْصِيرَ اِعْتَقَدُوهُ فِينَا وَ إِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا»[15] .
بعض خطابنا الديني يكرّر الروايات الموضوعة، ويغفل عن الكنز النبيل من الروايات الإنسانية التي تشع بالنور والرحمة والتسامح.
المحاور:
ذكرتم مشاهد مشرقة من سيرة أمير المؤمنين
، ويستطيع المتأمّل أن يجد المزيد من النماذج الرائعة في تعامله مع الآخر.
فمثلًا: نُقل أنه تقاضى يهوديًا في المحكمة في تساوٍ كامل للحقوق، ولم يُنقل عنه أبدًا أنه هدم كنيسة أو منع أحدًا من ممارسة شعائره الدينية.
بل ورد أنه مرّ على كنيسة، فقال له أحدهم: كَانَ يُشْرَكُ فِيهَا اللهِ كَثِيرًا؟ قَالَ
: «وَكَانَ يَذْكُرُ اللهِ فِيهَا كَثِيرًا»[16] .
هل نستطيع أن نستنبط من هذه المواقف رؤية واضحة في التعامل مع الآخر الديني؟
الشيخ الصفار:
بكل تأكيد.
السيرة العملية تُعد أوضح من كثير من الأقوال. فإن احتمل النص معنيين، فإن السلوك لا يحتمل التأويل.
والإمام علي  نفسه يقول فيما روي عنه: «أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِه، ويَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِه»[17] .
نفسه يقول فيما روي عنه: «أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِه، ويَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِه»[17] .
فالمطلوب أن نقتدي بسيرتهم، لا أن نكتفي بالافتخار بفضائلهم ومعاجزهم.
المحاور:
وإذا عدنا لسيرة رسول الله
، نجد مشاهد كثيرة تدعونا لتأملٍ عميق.
قصة اليهودي الذي كان يؤذي النبي بوضع الأذى أمام بابه، فلما مرض، عاده النبي.
هل في هذه المواقف دروس لهداية الآخرين أو طرائق للجذب؟
الشيخ الصفار:
نعم. إن أحد أبرز طرق الهداية لدى النبي والأئمة  هي علوّ الأخلاق.
هي علوّ الأخلاق.
لم يكن الهدف دائمًا هو التأثير، بل كان التعامل الإنساني الأخلاقي هو الأصل، حتى وإن لم يتحقق أثره.
فالرسول  لم يكن يُغيّر سلوكه تبعًا لاستجابة الآخر، بل لأنه مؤمن بهذه الأخلاق.
لم يكن يُغيّر سلوكه تبعًا لاستجابة الآخر، بل لأنه مؤمن بهذه الأخلاق.
لذلك ورد عنه  : «إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ»[18] .
: «إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ»[18] .
بعض الناس يظن أن هذه الأخلاق هدفها فقط جذب الآخرين.
لكن الحقيقة أعمق من ذلك.
حتى لو علم النبي أن الطرف الآخر لن يستجيب، فإنه يتعامل معه بأخلاق، لأنه مقتنع أن هذا هو السلوك الذي يجب أن يُمارس.
وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق  : «اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ، وَإِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ، فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ»[19] .
: «اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ، وَإِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ، فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ»[19] .
المحاور:
هذا يقودنا إلى التساؤل: كيف نفهم "الدعوة إلى الدين"؟
هناك روايات تؤكد على الهداية، مثل: "لَأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك مما طلعت عليه الشمس." لكن أيضًا هناك روايات تنهى عن الخصومة، مثل: "لا تخاصموا الناس لدينكم، فإن الخصومة ممرضة للقلب." كيف نجمع بين هذا وذاك؟
الشيخ الصفار:
لدينا بالفعل أبواب في كتب الحديث مثل: باب في ترك دعاء الناس، باب في ذم الخصومة، باب في التقية…
وكلها تشير إلى أهمية كبح جماح الجدل العقيم والانشغال بالصراعات اللفظية.
لكن بالمقابل، نجد في النصوص الإسلامية تأكيدًا على نشر الخير، سواء في الجانب المادي أو المعنوي.
فالخير المعنوي يشمل القيم، والمفاهيم، والعقائد، والأفكار التي نؤمن بصحتها.
ونجد في الحديث: "زكاة العلم نشره."
سواء علم دنيوي أو ديني، ما دام نافعًا، يجب نشره.
فالدين يأمر الإنسان أن يوصل كلمة الحق للآخرين، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة:
﴿ادْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾[سورة النحل، الآية: 125]
أما إذا كان الطرف الآخر غير مستعد، فيُستحسن تأجيل الدعوة، مراعاةً للظرف والحال.
المحاور:
وفي هذا السياق، تنقلون عن الإمام الصادق
: «مَا أَنْتُمْ وَالْبَرَاءَةَ، يَبْرَأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَراً مِنْ بَعْضٍ، وَهِيَ الدَّرَجَاتُ»[20].
وهذا يشير إلى التفاوت في المراتب الإيمانية، وضرورة الترفّق في التعامل.
فهل يشمل هذا أيضًا الاختلافات داخل المذهب؟
الشيخ الصفار:
التعصّب إذا تَغَلغل في النفس، يبدأ ضد الآخر الديني، ثم يتحول إلى تعصّب ضد المذهبي، ثم حتى ضد من يخالفك داخل نفس المذهب، ولو في مسألة فرعية!
رأينا هذا يحصل عند بعض المتشددين الذين ربّوا الناس على التكفير والتعصّب، كُفّروا لاحقًا من قبل تلاميذهم أنفسهم!
في السعودية مثلًا، بعض من كفّر المذاهب الأخرى، عاد تلاميذه لاحقًا فاتهموه بالكفر والضلال، فقط لاختلافه معهم في بعض التفاصيل!
هذا يُبيّن خطر التربية على التعصّب.
المحاور:
وهنا تأتي الروايات التي تُشدّد على التقييم الواعي لحال الطرف الآخر.
مثل الرواية التي وردت عن أبي بصير أنه قال للإمام جعفر الصادق: أَدْعُو اَلنَّاسَ إِلَى مَا فِي يَدِي؟ فَقَالَ
: لاَ. قُلْتُ إِنِ اِسْتَرْشَدَنِي أَحَدٌ أُرْشِدُهُ؟ قَالَ
: «نَعَمْ، إِنِ اِسْتَرْشَدَكَ فَأَرْشِدْهُ، فَإِنِ اِسْتَزَادَكَ فَزِدْهُ»[21] .
أي أن الدعوة لا تُطلق بلا نظر، بل بحسب الظرف والاستعداد.
الشيخ الصفار:
نعم. وأنا شخصيًا لا أُشجع على المناظرات المذهبية العقيمة، ولا على الجدل الذي يُعرض في الفضائيات ويُشحن به الرأي العام.
حتى لو التزم أحدهم بالطرح المؤدّب، فإن من يرد عليه غالبًا لا يلتزم بذلك، ويبدأ الشحن المتبادل.
هذه الأجواء تزرع الحقد والكراهية وتُشغل الناس عن قضاياهم الحقيقية.
لقد رأينا ما حدث بعد ما سُمّي بالربيع العربي: صراعات مذهبية، فتن داخلية، واحتراب مرير، وكل ذلك كان نتيجة أجواء مهيّأة بالتحريض والتفرقة.
المحاور:
لكن هناك من يرى في الحوار العلمي بين المذاهب وسيلة للتقارب والتنوير، ويعتقد أنه يمكن أن يلتقي العلماء لطرح الأدلة ومناقشتها بأدب واحترام.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الحوارات لا طائل منها، ولا تُنتج إلا مزيدًا من الانقسام، وأن الأصل التركيز على المشتركات، فما موقفكم من هذين الرأيين؟
الشيخ الصفار:
أنا أميل بوضوح إلى الرأي الثاني.
كل هذه الإشكالات المطروحة على الشيعة مثلًا ليست جديدة، وكذلك إجابات الشيعة ليست جديدة.
كل طرف قدّم حججه، ومضت قرون من الجدل.
بل أذكر بيانًا لسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني يقول فيه:
(تلك الخلافات التي مضى عليها قرون متطاولة، ولا يبدو سبيل الى حلّها بما يكون مرضيّاً ومقبولاً لدى الجميع، فلا ينبغي اذًا إثارة الجدل حولها خارج إطار البحث العلمي الرصين)[22] .
ليس من المناسب أن ننشغل اليوم كأمة بهذه الجدليات، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي نواجهها.
نعم، يمكن للعلماء أن يجلسوا في ندوات بحثية أكاديمية، يناقشون مسائل مختارة، لكن لا يجب أن نُشغل بها عامة الناس.
المحاور:
وهذا يقودنا إلى ما يُسمى بالحوار الديني الحضاري، كما نراه في مؤتمرات كبرى، يجتمع فيها علماء أديان ومذاهب وفلاسفة، يناقشون بعمق، وبروح راقية.
ولدينا في القرآن توجيه جميل في هذا الباب:
﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾[سورة الأنعام، الآية: 108]فكيف نُوفّق بين هذه الثقافة الأخلاقية الرفيعة، وبين آيات أخرى تربي الإنسان على لعن الظالمين والمفسدين؟ هل نحن أمام رؤيتين؟
الشيخ الصفار:
القرآن الكريم يدعو الناس للهداية، ويُعبّئهم ضد الظلم والفساد.
لكن اللعن في القرآن يأتي على الصفات لا على الأشخاص. ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾[سورة هود، الآية: 18]، ولا يذكر أسماءً محددة إلا إذا كانوا مجاهرين بالفساد.
لا يجوز أن نُنزل الآية على شخص بعينه دون محكمة عادلة، أو بيّنة واضحة.
حتى المجرمون لا يُحكم عليهم دون محاكمة.
الخطأ يكمن حين نُحوّل هذه الآيات إلى أداة للسب والشتم، ونُحمّلها أبعادًا لا تحتملها. القرآن يُريدنا أن نتربّى على الرفعة، لا على الانحطاط اللفظي.
المحاور:
وهذا يُعزّز ثقافة الحوار الأخلاقي. ولدينا أيضًا رواية عن الإمام موسى الكاظم
: «مَا تَسَابَّ اِثْنَانِ إِلاَّ اِنْحَطَّ اَلْأَعْلَى إِلَى مَرْتَبَةِ اَلْأَسْفَلِ»[23] .
الشيخ الصفار:
إن الله تعالى يقول: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
﴿وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.
والنبي  نفسه لم يقبل أسلوب الشتم، وقد وردت قصة الرجل الذي تهكم على النبي
نفسه لم يقبل أسلوب الشتم، وقد وردت قصة الرجل الذي تهكم على النبي  ، بقوله: إنْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَمَّا فِي بَطْنِ نَاقَتِي هَذِهِ.
، بقوله: إنْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَمَّا فِي بَطْنِ نَاقَتِي هَذِهِ.
فقال أحد الصحابة: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ. نَزَوْتَ عَلَيْهَا، فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخْلَةٌ.
فقال رسول الله  : «مَهْ، أَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ»[24] .
: «مَهْ، أَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ»[24] .
بل ورد أنه حين أسلم عكرمة بن أبي جهل، نهى النبي  أصحابه عن سبّ أبيه، رغم أفعاله، قائلًا: «يَأْتِيَكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ، فَإِنَّ سَبّ الْمَيّتِ يُؤْذِي الْحَيّ، وَلَا يَبْلُغُ الْمَيّت»[25] .
أصحابه عن سبّ أبيه، رغم أفعاله، قائلًا: «يَأْتِيَكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ، فَإِنَّ سَبّ الْمَيّتِ يُؤْذِي الْحَيّ، وَلَا يَبْلُغُ الْمَيّت»[25] .
القرآن والنبي وأهل البيت يريدوننا أن نتربّى على القول الطيب، لا على السباب واللعن.
لأن هذا الأسلوب لا يهدي، بل يُنفّر.
المحاور:
شيخنا، نختتم بمشهد من سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفّين، وقد سمع قومًا من أصحابه يسبّون أهل الشام. قال لهم: "إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين... ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعو عن الغي والعدوان من لهج به."
ما تعليقكم على هذا النص البليغ؟
الشيخ الصفار:
هذا النص يُبرز قمة الرقي في الأخلاق السياسية والاجتماعية عند الإمام علي  .
.
فهو لا يريد لأصحابه أن ينحدروا إلى أسلوب السبّ، بل يدعوهم إلى النقد الواعي، القائم على بيان الفعل والخطأ لا على الشتم والانفعال.
حين تشرح خطأ الطرف الآخر، تُتيح له فرصة التفكير، أما إن شتمته، فأنت تستفزه وتدفعه للتشبث بموقفه.
وقد رَبّانا الإمام على هذه الروحية في مواقف متعددة. فعندما تهجّم عليه أحد الخوارج قائلًا: (قاتله الله كافرًا ما أفقهه!)، غضب بعض أصحابه، وهمّوا به ليقتلوه، لكن الإمام  قال: «رُوَيْداً؛ إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ»[26] .
قال: «رُوَيْداً؛ إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ»[26] .
وعن الخوارج المعترضين عليه، قال  فيما روي عنه: «لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثاً مَا صَحِبْتُمُونَا: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا فِيهَا، وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا»[27] . حتى وهو يسمعهم يرددون: (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه)، قال
فيما روي عنه: «لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثاً مَا صَحِبْتُمُونَا: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا فِيهَا، وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا»[27] . حتى وهو يسمعهم يرددون: (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه)، قال  : «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ»[28] .
: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ»[28] .
هكذا يُعلّمنا الإمام كيف نحترم حتى المختلف، وكيف نحفظ القيم حتى في الخلاف.
المحاور:
وهذا المبدأ تجلى كثيرًا في سيرة النبي
أيضًا. حين كان الناس يُسيئون إليه، كان يقابل الإساءة بالإحسان، ويُعطي المحتاج، ويواسي الفقير. ألا تقول الآية: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؟ هل من شواهد رواياتية على هذا التعامل النبيل؟
الشيخ الصفار:
لدينا روايات مؤثرة جدًا. منها ما روي عن الإمام الباقر  حين قال لأحد صحابه: «إِنِّي أَرَاكَ لَوْ سَمِعْتَ رَجُلا سَبَّ عَلِيّا فَاسْتَطَعْتَ أَنْ تَقْطَعَ أَنْفَهُ فَعَلْتَ»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ لِي: «لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَسْمَعُ اَلرَّجُلَ يَسُبُّ عَلِيّا جَدِّي، فَأَتَوَارَى عَنْهُ، فَإِذَا فَرَغَ أَتَيْتُهُ فَصَافَحْتُهُ»[29] .
حين قال لأحد صحابه: «إِنِّي أَرَاكَ لَوْ سَمِعْتَ رَجُلا سَبَّ عَلِيّا فَاسْتَطَعْتَ أَنْ تَقْطَعَ أَنْفَهُ فَعَلْتَ»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ لِي: «لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَسْمَعُ اَلرَّجُلَ يَسُبُّ عَلِيّا جَدِّي، فَأَتَوَارَى عَنْهُ، فَإِذَا فَرَغَ أَتَيْتُهُ فَصَافَحْتُهُ»[29] .
الإمام يُربينا هنا ألا نتصرف بانفعال، بل بعقلٍ واتزان. وهكذا فعل مالك الأشتر، حين أُسيء له، فذهب للمسجد يستغفر لذلك الشخص[30] ، بدل أن ينتقم منه.
هذه هي مدرسة أهل البيت  : مدرسة الرحمة والوعي، لا ردود الفعل الغاضبة.
: مدرسة الرحمة والوعي، لا ردود الفعل الغاضبة.
المحاور:
وكثير من المفكرين والفلاسفة يرون أن جذور الخلافات والجدالات العقيمة إنما تعود إلى مناشئ أخلاقية: الحسد، الحقد، البغض، لا إلى الخلاف المعرفي الصرف.
ما تعليقكم؟ وهل ترون أن تعزيز البعد الروحي والأخلاقي والعرفاني هو الحل؟
الشيخ الصفار:
بلا شك. فإنه ورد عن النبي  : «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ»[31] .
: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ»[31] .
فالرسالة كلها أخلاق، ومن لا يهذب نفسه، قد يتحول إلى وحش ولو لبس عباءة التدين.
الشيطان طُرد من رحمة الله لا لأنه لم يعرف، بل لأنه تكبّر:
﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾[سورة الأعراف، الآية: 12]
فالخطر ليس في الجهل، بل في الغرور، لهذا، قال تعالى:
﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾[سورة النازعات، الآيتان: 40-41]
العبادة لا تنفع إذا لم تُصاحبها أخلاق، والقليل من العبادة مع النقاء القلبي أفضل من كثير يُشوبه الرياء.
ورد عن الإمام جعفر الصادق  : «الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ بِالْبَدَنِ»[32] .
: «الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ بِالْبَدَنِ»[32] .
المحاور:
ومتى يغضب المؤمن؟ متى يتخلى عن التسامح؟ هل هناك استثناءات؟
كيف نُوازن بين الغضب لله والالتزام بالأخلاق؟ وهناك أحاديث مثل: "إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يُظهر علمه."
الشيخ الصفار:
نعم، يُغضب المؤمن لله، لكن لا يخرج عن طاعة الله في غضبه.
ورد عن الإمام جعفر الصادق  : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ، وَإِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ»[33] ، حتى الغضب له حدود.
: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ، وَإِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ»[33] ، حتى الغضب له حدود.
لا يحق لك أن تُنزل الحدود الشرعية أو تُعاقب من تلقاء نفسك، فذلك من صلاحيات الحاكم الشرعي.
نعم، حين تظهر البدع، على العالم أن يُبيّن، أن يُظهر الحجة، أن يُنير الطريق.
لكن الرواية لم تقل: "فليسُب، أو ليُهين، أو ليُحرّض"، بل لتُقذف الحجة على الباطل.
ولا يصح التكفير للمسلم أو التحقير، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق  : «مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ، وَهَدْمَ مُرُوءَتِهِ، لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ»[34] .
: «مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ، وَهَدْمَ مُرُوءَتِهِ، لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَايَتِهِ إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ»[34] .
الغضب لله حق، لكن ضمن إطار العدل والرحمة.
المحاور:
وكيف نفهم مقاطع التوصيف في نهج البلاغة مثل قول أمير المؤمنين:
"ها هنا علماً جمًّا لو أصبت له حملة..." إلى آخر أوصافه لمن يستخدم الدين للدنيا أو ينقاد بغير بصيرة؟
الشيخ الصفار:
التوصيف مشروع، بل واجب أحيانًا، لكن إنزاله على أشخاص بعينهم هو موضع الإشكال.
نعم، نبّه الناس، حذّرهم من الانحراف، لكن لا تُسمِّ أحدًا دون بيّنة، وإلا كان ذلك ظلمًا وتشويهًا.
المحاور:
بارك الله فيكم شيخنا، كان حوارًا ماتعًا وثرِيًّا. هل لكم كلمة ختامية تلخص رؤيتكم لفلسفة الحوار والتسامح والنظر للآخر؟
الشيخ الصفار:
نحن حتى في اختلافاتنا داخل المذهب، قد لا نُكفّر الطرف الآخر، لكننا نمارس القتل المعنوي من خلال التحذير، التشويه، الإسقاط.
وهذا خطأ فادح.
خطابنا الديني اليوم مطالب بتعزيز احترام الرأي الآخر، وتقبّل التعددية، ونشر الوعي بأن الدين لا يُختزل في رؤية واحدة.
الشهيد الصدر قال: قد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة الخمسة في المئة من مجموع الأحكام[35] ، ووافقه المرجع الشيخ اسحاق الفياض، إذ يقول: الذي يتمتع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام الشرعية عن ستة في المئة[36] .
إذن: لماذا نصادر آراء بعضنا؟ لماذا ننزعج من اختلاف نظري؟
الاجتهاد مفتوح، والخلاف مشروع، والمطلوب أن نتعايش باحترام.
فحين نحسن الظن، ونهدأ في اختلافنا، نصبح أقرب إلى الله، وأقرب إلى رسوله، وأقرب إلى أهل البيت (عليهم السلام).
المحاور:
جزاكم الله خيرًا شيخنا، وشكرًا على هذه الضيافة الكريمة وحفاوة الاستقبال.
الشيخ الصفار:
أهلاً وسهلاً بكم، أنتم تُشكرون على زيارتكم وتحمّلكم عناء السفر.
نسأل الله أن يُثيبكم، ويبارك في جهودكم.