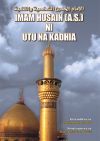اختلاف الرأي لا يوجب العداوة
قد تعادي شخصاً لأنه أساء لك أو اعتدى على حق من حقوقك، وهذا موقف مفهوم مشروع، وقد تعادي شخصاً لأنه ينافسك أو يزاحمك على مصلحة من المصالح أو مكسب من المكاسب، وهو أمر وارد وقابل للنقاش، أما أن تعادي شخصاً لأن له رأياً يخالف رأيك في قضية علمية أو دينية أو سياسية، فذلك موقف لا يسوّغه لك الشرع ولا العقل.
الرأي: شأن خاص
والرأي كما في اللغة: هو الاعتقاد، والجمع آراء. أي ما اعتقده الإنسان وارتآه. تقول رأيي كذا، أي اعتقادي. والاعتقاد والعقيدة: ما عقد عليه القلب والضمير، وما تديّن به الإنسان واعتقده.
وبذلك فالرأي من شؤون قلب الإنسان، وهو من أخص خواصه الذاتية الشخصية، فلا يحق لأي أحد أن يتدخل في هذا الشأن بالقسر والقوة، كما أن التدخل في هذه المنطقة المحرّمة لا يجدي ولا يؤثر، فإذا ما حاولت أي قوة أن تفرض على إنسان رأياً أو تمنعه من رأي، فإنها لن تستطيع إلا إخضاعه ظاهراً، أما قراره الداخلي، وإيمانه القلبي، فيستعصي على الفرض والإكراه.
لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينفي إمكانية الإكراه على الدين وينهى عنه يقول تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾256/البقرة.
ورائع جداً ما قاله العلامة الطباطبائي حول هذه الآية الكريمة قال: وفي قوله تعالى ﴿لا إكراه في الدين﴾، نفي الدين الإجباري، لما أن الدين وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، والاعتقاد والإيمان من الأمور القلبية التي لا يحكم فيها الإكراه والإجبار، فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات البدنية المادية، وأما الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد والإدراك، ومن المحال أن ينتج الجهل علماً، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقاً علمياً، فقوله ﴿لا إكراه في الدين﴾، إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكماً دينياً ينفي الإكراه على الدين والاعتقاد، وإن كان حكماً إنشائياً تشريعياً كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾، كان نهياً عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرها، وهو نهي متك على حقيقة تكوينية، وهي التي مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية.[1]
من هذا المنطلق فإن التظاهر بالكفر إذا كان ناتجاً عن ضغط وإكراه، فهو مشروع ولا يناقض الإيمان المستقر في القلب، يقول تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ 106/النحل ويعبّر عن ذلك في الاصطلاح الشرعي بالتقيّة، والتي هي: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق، اقتباساً من قوله تعالى: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ 28/آل عمران .
فالرأي والاعتقاد لا يغيّره الضغط والقهر، والتظاهر بالتخلي عن ذلك الرأي لا يزيله من قرارة نفس الإنسان، بل قد يزداد ثبوتاً ورسوخاً، بدافع التحدي ورد الفعل.
كما ينقل عن قصة العالم الإيطالي (غاليليو غاليلي 1564-1642م) والذي اعترضت الكنيسة المسيحية وعلماء اللاهوت على آرائه العلمية حول حركة الأرض وأنها ليست مركز العالم، ولا هي ساكنة، بل تتحرك وتدور يومياً، وأن الشمس هي المركز، واتهم بالهرطقة والخروج عن الدين، وجلبوه إلى روما للمثول أمام محكمة التفتيش، فاعتقل في الحال، ثم استنطق وحقق معه بعد شهرين، وهدد بالتعذيب، ثم أصدرت المحكمة حكمها بأن يعلن (غاليليو) التوبة، ويتنكر لآرائه العلمية، فحضر أمام المحفل الكنسي، وركع على ركبتيه وراح يقرأ ما أجبر على قوله، لكنه عند خروجه من المحكمة عقّب قائلاً: (ومع ذلك فهي تدور) يقصد الأرض[2].
وقد أعطى الله سبحانه وتعالى المجال للإنسان في هذه الحياة ليمارس حرية الرأي والمعتقد، فلم يفرض عليه الإيمان به عنوة، بل أنار له طريق الهداية، وترك له حرية الاختيار ﴿إنا هديناه السبيل. إما شاكراً وإما كفورا﴾2/ الإنسان.
﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾29/ الكهف.
ولم يسمح الله تعالى حتى لأنبيائه أن يصادروا من الإنسان حرية رأيه واختياره، فهم يعرضون رسالة الله على الناس، دون فرض أو إكراه ﴿فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾21-22/ الغاشية ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾99/ يونس
وإذا كان للرأي هذه الخصوصية في نفس الإنسان، والموقعية في شخصيته، فكيف يحق لك أن تتدخل في هذه الخصوصية، وأن تعادي إنساناً أو تسيء إليه لأنه يمارس شأنه الخاص به في أعماق نفسه؟
إننا نعترف للآخرين بخصوصيتهم في سائر المجالات، كالأكل والشرب مثلاً، فلو رأيت إنساناً يعادي شخصاً لأنه لا يرغب في نوع معين من الطعام، أو يعزف عن لون آخر، لاستنكرت عليه ذلك، على اعتبار أن هذه الرغبات شأن خاص لا علاقة للآخرين بها، والحال أن الرأي آكد خصوصية، وأشد التصاقاً بنفس الإنسان.
اجعل نفسك ميزاناً:
وأنت حينما تعادي زيداً أو عمراً لأنه يخالفك في هذا الرأي أو ذاك، هل ترضى أن يعاديك الآخرون على هذا الأساس؟ إنك لا تقبل أن يسيء إليك أحد لأنك تحمل رأياً معيناً، حيث تعتبر ذلك شأناً خاصاً بك، وتعتقد بأحقية رأيك، وعليك أن تعرف أن الآخرين يرون لأنفسهم ما ترى لنفسك.
وفي وصيته الخالدة لابنه الحسن
 يقول الإمام علي
يقول الإمام علي  : (يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تَظِلم كما لا تحب أن تُظلم، وأحسِن كما تحب أن يُحسن إليك، وأستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارضَ من الناس ما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قلَّ ما تعلم، ولا تقل مالا تحب أن يقال لك)[3]
: (يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تَظِلم كما لا تحب أن تُظلم، وأحسِن كما تحب أن يُحسن إليك، وأستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارضَ من الناس ما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قلَّ ما تعلم، ولا تقل مالا تحب أن يقال لك)[3]إنها قواعد أساسية هامة في تعامل الإنسان مع الآخرين، ترجعه إلى ضميره ووجدانه، قبل أي شيء آخر.
احتمال الخطأ والصواب:
يبالغ بعض الناس في التعصب لآرائهم، ويفرطون في الثقة بها، بحيث لا يفسحون أي مجال ولا يعطون أي فرصة للرأي الآخر، فهم على الحق المطلق دائماً، وغيرهم على الباطل في كل شيء.
وينتج عن هذه الحالة –غالباً- موقف التطرف والحديّة تجاه المخالفين، وحتى في الاختلاف عند بعض القضايا الجزئية، والأمور البسيطة الجانبية.
إنه خلق يخالف تعاليم الإسلام الذي يربي أبناءه على الاستماع لمختلف الآراء ومحاكمتها على أساس الدليل والمنطق، لا التعصب والانفعال. يقول تعالى: ﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونَ أحسنه﴾17-18/الزمر
وأكثر من ذلك فإن رسول الله
 والذي لا يشك في أحقية دعوته بمقدار ذرة واحدة، يخاطب المشركين بمنتهى التواضع والموضوعية قائلاً ﴿وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾24/سبأ. إنه منهج تربوي عظيم، يصوغ شخصية الإنسان على أساس احترام الآخرين، ومركزية العقل والوجدان.
والذي لا يشك في أحقية دعوته بمقدار ذرة واحدة، يخاطب المشركين بمنتهى التواضع والموضوعية قائلاً ﴿وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾24/سبأ. إنه منهج تربوي عظيم، يصوغ شخصية الإنسان على أساس احترام الآخرين، ومركزية العقل والوجدان.والتعصب المطلق للرأي، والحدية والتشنج تجاه آراء الآخرين، يمنع الإنسان من الانفتاح على الرأي الآخر، واستماعه والإطلاع عليه، وربما كان هو الرأي الصحيح والصائب. ثم أن ذلك قد يجعل الإنسان في موقف حرج مستقبلاً إذ قد يتبين له خطأ رأيه، فكم من إنسان تراجع عن رأيه، وتغيرت قناعاته؟ وتلك حالة طبيعية قد تحصل للإنسان تجاه مختلف المسائل والقضايا.
يقول شاعر المهجر إيليا أبو ماضي:
رب فكر بان في لوحـة نفسي و تجلى *** خلتـه مني و لكـن لم يقـم حتى تولى
مثل طيف بان في بئـر قليلاً واضمحلا *** كيف وافى و لماذا فرّ مني؟ لست أدري.
وقد رأينا أناساً كانوا يبالغون في التعصب لآرائهم حول بعض المسائل والأشخاص والجهات، ويعتبرون القول بهذا الرأي هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، أو يعتقدون أن الولاء لهذا الشخص أو لهذه الجهة هو مقياس الحق والباطل، ويعادون الناس ويناوؤنهم على هذا الأساس. لكنهم بعد فترة من الزمن تغيرت قناعاتهم وآراؤهم، مئة وثمانين درجة، مما أوقعهم في حرج مع أنفسهم وتجاه الناس.
إن الاعتدال والوسطية هو المنهج السليم، فلا يكون الإنسان متطرفاً ولا متشنجاً حاداً في مواقفه مع الآخرين، وعلى هذا المعنى يحمل قول أمير المؤمنين علي
 : «أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»[4]
: «أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»[4]وجميل ما قاله أحد العلماء: إن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
تفّهم مواقف الآخرين:
حينما تعتقد أحقية رأي معين، وتجد آخرين يخالفون هذا الرأي الحق –في نظرك- فإن عليك قبل أن تتهمهم بالعناد والجحود والمروق، وأن تتخذ منهم موقفاً عدائياً، عليك أن تتفهم ظروفهم وخلفية مواقفهم.
فلعل لديهم أدلة مقنعة على ما يذهبون إليه.
أو لعلهم يجهلون الرأي الحق، لقصور في مداركهم ومعلوماتهم.
أو لعلهم يعيشون ضمن بيئة وأجواء تحجب عنهم الحقائق.
أو لعلّ هناك شبهات تشوّش على أذهانهم وأفكارهم.
وتجاه مثل هذه الاحتمالات فإن المطلوب منك هو دراسة موقف الطرف الآخر، ومعرفة وجهة نظره، والدخول في حوار موضوعي معه، ومساعدته على الوصول إلى الحقيقة.
ونشير هنا إلى ملاحظة دقيقة هي: أن الإنسان قد يؤمن برأي من الآراء، ويعتبره حقيقة واضحة، تصل إلى مستوى المسلمات والبديهيات، لأنه قد أشبع الأمر بحثاً، وانشد إليه نفسياً، وعاش ضمن محيط قائم على أساس ذلك الرأي، فالمسألة أمامه واضحة جلية لا نقاش فيها، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للآخرين.
(إن وضوح الفكرة لدينا لا يعني أن الآخرين ينظرون إليها بنفس الوضوح، فربما كنا نتطلع إليها من خلال الجوانب المضيئة عندنا، بينما يكون عنصر الضوء غير متوفر في الجوانب الأخرى التي يعيش فيها الآخرون، لأنهم لا يملكون ما يهيئ لهم ذلك، تماماً كما يكون الصحو في بعض الآفاق مجالاً للانطلاق مع إشعاع الشمس، بينما تجعل السحب الدكناء الآفاق الأخرى في ظلام دامس. وقد يبدو هذا طبيعياً عندما نلاحظ اختلاف وجهات النظر في فهم بعض الأشياء العادية في الحياة، كنتيجة طبيعية لاختلاف العادات والظروف والأفكار. ولعل قيمة هذا الاتجاه، في ملاحظة موقعنا تجاه الآخرين، تبرز في إتاحة الفرصة لنا في الانطلاق نحو موضوعية أكثر وفهم أرحب، في سبيل تعرف وجهة النظر الأخرى، من حيث طبيعة الفكرة التي يؤمنون بها من جهة، ومن حيث طبيعة الموقف الذي يتخذونه منا، من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلنا أكثر قدرة على الحركة بوعي، وعلى ضوء الأجوبة الصحيحة لما يرد من التساؤلات، ومعالجة القضايا المعروضة في مجالات البحث)[5]
ويربينا القرآن على هذا النهج الموضوعي حينما يتحدث عن فئآت من الرافضين لرسالات الأنبياء، بأن سبب ذلك الرفض هو الجهل وعدم العلم، كقوله تعالى: ﴿ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾6/التوبة. وقوله تعالى: ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾37/الأنعام. ويقول تعالى: ﴿ذلك مبلغهم من العلم﴾30/النجم.
فنبي الله نوح
 في بدء رسالته يخاطب قومه مبدياً تفهمه لظروفهم التي تجعلهم يرفضون رسالته، بسبب التشويش على أذهانهم، ووجود الشبهات التي تعيق تفكيرهم، مع أنه يحمل إليهم الدعوة الصادقة، والحجة الواضحة مطالباً لهم بتجاوز تلك الحواجز ليروا الحق. يقول تعالى: ﴿قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعمّيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون﴾28/هود.
في بدء رسالته يخاطب قومه مبدياً تفهمه لظروفهم التي تجعلهم يرفضون رسالته، بسبب التشويش على أذهانهم، ووجود الشبهات التي تعيق تفكيرهم، مع أنه يحمل إليهم الدعوة الصادقة، والحجة الواضحة مطالباً لهم بتجاوز تلك الحواجز ليروا الحق. يقول تعالى: ﴿قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعمّيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون﴾28/هود.وفي لفتة تربوية معبرة يتحدث القرآن الكريم عن بني إسرائيل بعد نجاتهم من الغرق مع نبي الله موسى
 ، وطلبهم منه أن يجعل لهم أصناماً كما للمشركين أصنام!! ومع سخافة الطلب ومخالفته الواضحة للدين، إلا أن نبي الله موسى
، وطلبهم منه أن يجعل لهم أصناماً كما للمشركين أصنام!! ومع سخافة الطلب ومخالفته الواضحة للدين، إلا أن نبي الله موسى  أرجع ذلك إلى جهلهم، ثم صار يقرر عليهم حقيقة التوحيد من جديد، يقول تعالى: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين﴾138-140/الأعراف.
أرجع ذلك إلى جهلهم، ثم صار يقرر عليهم حقيقة التوحيد من جديد، يقول تعالى: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين﴾138-140/الأعراف.وصلوات الله تعالى على نبينا نبي الرحمة محمد
 الذي كان يدعو الله تعالى لهداية قومه قائلاً: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
الذي كان يدعو الله تعالى لهداية قومه قائلاً: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.مسؤولية الرأي على صاحبه:
إذا ما أصر إنسان على رأي خاطئ، ورفض قبول الحق والصواب، فإنه هو الخاسر بالدرجة الأولى، وسيدفع ثمن خطئه، ويتحمل مسؤولية رأيه، وما على المهتدين للحق إلا إرشاده وتوضيح الحقائق له، ثم هو بعد ذلك له كامل الحرية والاختيار، فإن استجاب فقد نفع نفسه، وإن أبى فهو المتضرر.
فمن يريد الذهاب إلى السوق لكنه يسلك طريقاً معاكساً فإن مسئوليتك تنتهي عند حدود تبيين الطريق له، فإذا ما أصر على سلوك الطريق المعاكس، فإنه لن يصل إلى السوق التي يريدها، والطبيب مهمته أن يقدم العلاج للمريض لكنه إذا لم يلتزم بالعلاج، فسيدفع الثمن من صحته.
ولا داعي لكي يزعج الإنسان نفسه، ويدخل في معارك العداء مع الآخرين لأنهم لم يقبلوا الرأي الذي يراه حقاً.
إن البعض يأخذهم الحماس لمبادئهم وآرائهم بحيث يضغطون على أعصابهم ويتأزمّون نفسياً ويتجاوزون الحدود في التعامل مع الناس، وكأن لهم الوصاية والسيطرة على أفكار الآخرين وتوجهاتهم، وهذا خطأ فظيع.
لقد كان رسول الله
 حريصاً على هداية قومه، إلى حد أنه كان يجهد نفسه أكثر من اللازم، فجاءه التوجيه من الله سبحانه: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾3/الشعراء. أي مهلك نفسك.
حريصاً على هداية قومه، إلى حد أنه كان يجهد نفسه أكثر من اللازم، فجاءه التوجيه من الله سبحانه: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾3/الشعراء. أي مهلك نفسك.ومرة أخرى يخاطبه الباري جلّ وعلا: ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى﴾2-3/طه. أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم، وتحسّرك على أن يؤمنوا [6] .
وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد على أن مهمة النبي والداعية تنتهي عند حدود التبليغ والإرشاد، ولا يصح تجاوز هذه المهمة إلى حد ممارسة الوصاية والضغط على الآخرين. يقول تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا﴾80/النساء.
ويقول تعالى: ﴿وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾20/آل عمران.
وهناك روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على تجنب العداء والخصومة مع الآخرين على أساس الاختلاف في الدين والرأي كما روي عن الإمام الصادق
 : «إياكم والخصومة في الدين»[7]
: «إياكم والخصومة في الدين»[7]وورد عنه في رواية أخرى: «فلا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس»[8]
إن هذه التوجيهات الربانية والمفاهيم القرآنية، وسيرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام تردع الإنسان عن أن يكون حاداً متشنجاً مع من يخالفه في الدين والرأي، أو أن يجعل اختلاف الرأي سبباً ومبرراً للعداء والخصومة.
العداوة تمنع التأثير:
إذا كنت مخلصاً لأفكارك، ومتحمساً لنشرها، واستقطاب الآخرين باتجاهها، فإن الطريق لذلك هو الانفتاح على الآخرين، وخلق جو من الاحترام والودّ معهم.
فوجود علاقة لك بهم، وتواصل بينك وبينهم، يتيح لك الفرصة لعرض أفكارك وآرائك عليهم، أما القطيعة والعداء، فإنها تسلب منك هذه الإمكانية، وتفقدك الرغبة والاندفاع في تكرار محاولة التأثير عليهم.
من ناحية ثانية فإن حالة العداء وما تفرزه من سلوكيات منفرة تحول بين الطرف الآخر وبين الإقبال والاستجابة.
فالعاقل الواعي الذي يريد خدمة أفكاره، وأن تشق طريقها إلى قلوب الناس، هو الذي يمتلك سعة الصدر ورحابة الأفق، ولا ينفعل تجاه الرأي المخالف، حتى ولو تعامل معه الآخرون بشكل سيئ، فإنه يمارس أعلى درجات ضبط النفس، والتحكم في الأعصاب، بحيث يقابلهم باللطف والإحسان، فيمتص التشنجات، ويستوعب الاستفزازات.
وبهذه المنهجية الأخلاقية يدفعهم لإعادة النظر في موقفهم تجاهه، ويشجعهم على الانفتاح على أفكاره، مما قد يغيّر قناعاتهم، ويستقطبهم إلى جانبه وإلى صف رأيه.
ويؤكد القرآن الكريم تأثير أسلوب الرفق والإحسان وأنه يساعد على تغيير المواقف والنفوس لصالح الدعوة والرسالة، في قوله تعالى: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾34-35/فصلت.
فالمنهجية الحسنة القائمة على أساس اللطف والاحترام والود مع الآخرين، تختلف في نتائجها عن المنهجية السيئة المعتمدة على الشدة والقطيعة والعداء، فالأولى تفتح الطريق أمام التأثير والكسب، بينما الثانية تسبب النفور وتزيد هوّة التباعد.
لكن المنهجية الحسنة لا تتوفر إلاّ لمن يروّض نفسه على الصبر تجاه الإساءات والاستفزازات، ويمتلك نصيباً عظيماً من الأخلاق الفاضلة.
وينهى الله سبحانه عباده المؤمنين من أن يتحدثوا مع المخالفين لهم في الدين إلا بأفضل أسلوب، وأحسن طريقة، رعاية لمشاعرهم يقول تعالى ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾46/العنكبوت.
لقد واجه رسول الله
 في بداية الدعوة معارضة ومخالفة عنيفة من قبل المشركين، ولكنه تغلب على كل ذلك بأخلاقه العظيمة ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ ولولا ذلك الخلق الرفيع لما تمكن الرسول
في بداية الدعوة معارضة ومخالفة عنيفة من قبل المشركين، ولكنه تغلب على كل ذلك بأخلاقه العظيمة ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ ولولا ذلك الخلق الرفيع لما تمكن الرسول  من هداية ذلك المجتمع الجاهلي الغارق في الفساد والتخلف، يقول تعالى: ﴿ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾159/آل عمران.
من هداية ذلك المجتمع الجاهلي الغارق في الفساد والتخلف، يقول تعالى: ﴿ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾159/آل عمران.وهكذا فإن على من يعتبرون أنفسهم حملة للحق، وذوي الفكر الصحيح والرأي الصائب، أن يتحلّوا بمصداقية أخلاقية في التعامل مع الناس، وخاصة المخالفين لهم في المذهب أو الرأي أو الموقف، فإن القطيعة والعداوة والإساءة، تخالف تعاليم الدين، وتصادم توجيهات العقل، وتشوّه دعوة وفكرة أصحابها، وتنفّر الناس منهم.
منهج الإسلام وسيرة السلف
من الظواهر المؤسفة في بعض الأوساط الدينية، سوء التعامل مع المخالفين في الدين أو المذهب أو الاتجاه، حتى أصبحت الغلظة والفظاظة والتجهم والتشدد سمة من سمات التدين عند هؤلاء، وأصبح حتى الاختلاف على بعض المسائل الجزئية الاجتهادية سبباً للقطيعة والعداء.
وهذا مخالف لنهج الإسلام، ولسيرة السلف الصالح، من أئمة أطهار وصحابة أخيار. فالقرآن الكريم يشجع المسلمين على حسن التعامل والبر بالكافرين غير المحاربين والمعتدين يقول تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾8-9/الممتحنة.
(أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين، والإخراج من دياركم. فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا تبعة)[9]
وفي سيرة رسول الله
 أروع الصور الإنسانية، وأسمى المواقف الأخلاقية في التعامل مع الكافرين من يهود ونصارى ومشركين، ليس في العهد المكي فقط، وإنما في العهد المدني وبعد أن جاء نصر الله والفتح.
أروع الصور الإنسانية، وأسمى المواقف الأخلاقية في التعامل مع الكافرين من يهود ونصارى ومشركين، ليس في العهد المكي فقط، وإنما في العهد المدني وبعد أن جاء نصر الله والفتح.وفي معالجة نقدية لظاهرة التشدد عند بعض المتدينين تجاه مخالفيهم كتب الباحث السعودي الدكتور عبد الله الحامد مقالة جميلة تحت عنوان (هل ينبغي أن نكون أكثر سلفية من السلف؟) نقتطف منها ما يلي: (ويبدو تعامل الخليفة الراشد، علي بن أبي طالب مع الخوارج، نموذجاً واضحاً، لا ليل فيه ولا ضباب، لاسيما أنه خليفة راشد مجتهد، يدرك علاقة القاعدة بالنموذج، وعلاقة النص بالتطبيق.
ولعل من المفيد –قبل استنباط التعريف من موقفه- أن نتذكر ما اشتمل عليه مذهب الخوارج من مخالفات واضحات، لأمور قطعية الثبوت والدلالة:
أولها/ أنهم اعتبروا مرتكبي كبائر الذنوب كفاراً، مخلدين في جهنم، إن لم يتوبوا قبل الممات، وهذا الاعتقاد مخالف لنصوص الكتاب والسنة.
ثانيها/ أنهم يردون الأحاديث الواردة، عن طريق عثمان وعلي رضي الله عنهما، ومن شايعهما.
ثالثهما/ أنهم كفروا الصحابة المشهود لهم بالجنة، كعثمان وعلي، وطلحة والزبير، وكفروا أصحاب الجمل، والحكمين ومن رضي بحكمهما، وكثيراً من الصحابة.
رابعها/ أنهم استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم واستحلال دم المسلم محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وفي ذلك إخلال كبير خطير بالقطعيات.
وعلى رغم كل هذه الانحرافات الفكرية والسلوكية، لم يكفرهم الخليفة، ولا جمهور الصحابة، على رغم أن تكفيرهم، هو ظاهر الأمر عند عدد آخر، من الفقهاء والعلماء، فقد وردت أحاديث صحيحة في ذمهم، منها أنهم «يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية» وكان يمكن لعلي أن يستثمر الأحاديث التي توحي بكفرهم، لأن مروق الإنسان من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، ظاهره الخروج من الدين.
ولكن علياً كان أوعى وأدرى بأحكام التكفير، وكان على درجة فريدة من إنصاف الأعداء والخصوم، فهذا الرجل الذي عاقب الذين غلوا في حبه حتى ألهوه، لم يكفر الذين كفروه وقاتلوه، وإنما قاتلهم لأنهم بغاة محاربون، ولم يقاتلهم على اعتبار أنهم كفار، ولما سئل أكفار هم؟ قال: «من الكفر فروا»، لما سئل أمنافقون هم؟ قال: «المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا» ولما قيل له: إذن من هم قال: «إخواننا بغوا علينا».
وبدعة الخوارج تعتبر أشد أنواع الابتداع في الإسلام، كما قال أحمد بن حنبل، رحمنا الله وإياه: (لا أعلم قوماً -أي من أهل الابتداع- شراً من الخوارج).
وإنما اعتبر الخوارج غير كفار، لأن بدعهم بدع تأويل، وليست بدع إنكار، لأن تأويل القطعيات (ما لم تكن من أصول الدين، كالصلاة والحج) غير مكفر، أما إنكارها من دون تأويل فهو مكفر.
وموقف علي وجمهور الصحابة، من انحراف الخوارج الفكري، يضرب نموذجاً إسلامياً فذاً، في التسامح مع المخالفين، وبذلك يتمظهر الإسلام أكثر إنصافاً، وإقراراً للحقوق الإنسانية، من دعاة الحرية العلمانية، الذين قال أحد زعمائهم الفرنسيين (سان جوست) (لا حرية لأعداء الحرية)، أي لا ديموقراطية لأعداء الديموقراطية.
دستور الدولة الإسلامية –كما نمذجه علي بن أبي طالب- يعترف بكل فئة موجودة في الساحة،حتى الذين لا يعترفون به يعترف بهم، حتى الذين يريدون استئصاله وإسقاطه، مثل دعاة الاستئصال في الفكر الإسلامي (كقدامى الخوارج والمعتزلة، والمتأثرين بردود أفعالهم)، كالديانات الأخرى، التي لا تعترف بالإسلام.
وهذا يدل أيضاً على سعة أفق الإسلام وسماحته، تجاه أهل البدع، وتجاه الأفكار والآراء، وتجاه النقد بالكلمة الحرة. وأنه لا يجيز النيل من أجسادهم، ولا أعراضهم ولا أموالهم، ولا يجيز التضييق عليهم، أو حبسهم حتى يتوبوا، بل ولا يجيز حرمانهم من حقوقهم المدنية، ولا سيما الحقوق الوظيفية والمالية، فقد أعلن علي للخوارج، وهو يخطب على المنبر: أن لهم حقاً في بيت المال، لن يمنعهم إياه، (وهم يقاطعون الخطبة بتكفيره)!.
ويأتي تطبيق علي رضي الله عنه، كالشمس قوة وإضاءة، للنص النظري، للاعتبارات الآتية:
1. أنه ثاني الأربعة الكبار من الصحابة (عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس)، الذين برزوا في الفقه العام والقانوني.
2. أنه حاكم الدولة، الذي يدرك العلاقة بين النص والتطبيق.
3. أنه أطول الخلفاء الراشدين خبرة عملية، فقد عاش معهم تحت ظلال الوحي، وتطبيق الرسول
 ، ثم كان مستشاراً كبيراً للخلفاء الثلاثة من قبله.
، ثم كان مستشاراً كبيراً للخلفاء الثلاثة من قبله.4. أنه فعل ذلك، وهو في حال الصراع، التي تختلط فيها الأشياء، وتجر الناس إلى الحدة والشدة، ويصعب على الناس العاديين أن يتجردوا من الذاتية، حين يتحرون الموضوعية، وكان بإمكانه أن يستل سيف التعزيز، وأن يمتطي مطية المصالح المرسلة، وأن يفعل ما يقول بعض الفقهاء العباسيين: يجوز قتل ثلثي الناس لاستصلاح الثلث الباقي!.
ولكنه يدرك أن النجاح والذكاء السياسي، لا ينبغي أن يتما على جثة الصدقية الأخلاقية، لأن الأشخاص يموتون، والمبادئ العادلة المستنيرة تحيا، لكي تحيا بها الأمم، فكان هذا الموقف تجسيداً حياً، للديموقراطية الإسلامية)[10]
وأخيراً:
فإن اختلاف الرأي ظاهرة طبيعية في حياة البشر، ولا يصح أن تكون سبباً للتعادي والتخاصم، بل ينبغي أن تستثمر لصالح تكامل المعرفة، واكتشاف الحقيقة، وإثراء الساحة الثقافية.
وأفضل خدمة تقدمها للرأي الذي تؤمن به، حسن تعاملك مع الآخرين، لتقدم بسلوكك الطيب أنموذجاً مقبولاً لأفكارك، ولتكون بسيرتك الصالحة داعية لآرائك، أما أسلوب العداوة والتشدد، فهو يسيء إلى التوجه الذي تنتمي إليه أولاً، وإليك ثانياً.