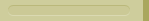أنسنة المدن
يقول تعالى: ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: 37].
يقول العلماء الباحثون في التاريخ الإنساني، إنه قبل حوالي عشرة آلاف سنة، لم تكن هناك أماكن يتوطن فيها الناس ويقيمون فيها إقامة دائمة، بل كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر لصيد الحيوانات وجمع النباتات للطعام.
وفيما أطلق عليه العصر الحجري، منذ حوالي عشرة آلاف سنة، بدأ قسم منهم يعيشون في مستوطنات دائمة، وهم المزارعون الأوائل الذين اعتمدوا على الزراعة كمصدر لغذائهم، ولم يعودوا بحاجة إلى التنقل، فتكونت لهم قرى متناثرة يقيمون فيها.
وبعد زمن كان لبعض هذه القرى إنتاج زراعي فائض صاروا يبيعون منه للآخرين، وينتجون بعض المصنوعات، كما استأنسوا الحيوانات واستخدموها في أعمالهم، وكانت من مصادر غذائهم، فتوسعت تلك القرى وتنوعت فيها مجالات العمل، وكان ذلك بداية لتأسيس المدن قبل حوالي ستة آلاف سنة.
ومع مرور الزمن اتسعت بعض تلك المدن وأصبحت حواضر كبيرة يعيش فيها الآلاف من الناس، لكنّ الأكثرية من البشر كانت حياتهم في القرى والأرياف.
وإلى ما قبل حوالي 200 سنة، أي في القرن التاسع عشر الميلادي، كان حوالي 2.5% فقط من سكان العالم يقطنون الحواضر.
وقفز هذا الرقم إلى حوالي 40% سنة 1980م([1]9.
وبحسب هيئة الأمم المتحدة حتى عام 2009م كان من يعيشون في المناطق الريفية أكثر عددًا ممن يعيشون في المناطق الحضرية، أما اليوم فيعيش حوالي 55% من سكان العالم في المدن، ومن المتوقع أن يصل مستوى التوسع الحضري إلى ما يقرب 60% عام 2030م، و70% بحلول عام 2050م.
المدينة وتحدّيات تطور الحياة
هذه الهجرة المتصاعدة من القرى والأرياف بحثًا عن فرص العمل وانجذابًا للخدمات الأفضل، جعلت المدن الرئيسية في مختلف أنحاء العالم تواجه تحدّيات كثيرة بسبب الكثافة السكانية، وازدحام الطرق، والضغط الشديد على البنى التحتية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص المساحات الخضراء، وتغيّر المناخ لوجود المصانع ووسائل النقل، والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك ضعف العلاقات الاجتماعية بسبب كثرة انشغال الناس في المدن وغلبة النزعة المادية الفردية.
وإدراكًا لهذه التحدّيات، وسعيًا لمواجهتها والتخفيف من تداعياتها، أطلقت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمدن عام 2014م، وهو اليوم الحادي والثلاثون من شهر أكتوبر كلّ عام.
وظهر مصطلح (أنسنة المدن)، لجعل المدينة أكثر ملاءمة للبعد الإنساني وأقرب إلى الطبيعة، ولتحقيق جودة الحياة.
فإنه مع التقدّم الصناعي والتقني، أصبحت المدن شبه صناعية، حيث تركّز على الطرق والسيارات والآلات والمباني الشاهقة، ويضعف التّركيز فيها على النواحي الإنسانية والطبيعية.
والاحتفاء باليوم العالمي للمدن هذا العام يأتي تحت شعار (المدن الذكية التي ترتكز على الإنسان)، فقد جاء في بيان الأمم المتحدة بهذه المناسبة: (إنّ اليوم العالمي للمدن يحمل رسالة إنسانية وحضارية واضحة: المدن الذكية ليست مجرّد شبكات من البيانات والتجهيزات، بل فضاءات صُمّمت لتحتضن الإنسان وتستجيب لتطلعاته. ويُراد من هذا اليوم إذكاء الوعي بمفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الناس، وفتح فضاءات للحوار وتبادل الخبرات بين المدن المختلفة)[2] .
معالم أنسنة المدن
إنّ أنسنة المدن يعني أن تكون المدينة أكثر ملاءمة وجاذبية للإنسان، تمكنه من الاستمتاع بحياته وتطوير إمكاناته الفكرية والعملية والاجتماعية.
ومن أهم معالم الأنسنة في المدن الاهتمام بالبيئة الطبيعية والجوانب الصحية، عبر إنشاء مناطق مفتوحة، مثل الساحات البلدية والملاعب والحدائق والمسطحات الخضراء، وإنشاء شبكة من ممرات المشاة، وتطوير الأماكن الترفيهية للاحتفالات والمهرجانات، وخلق بيئة صحية مستدامة، لتحسين صحة ورفاهية السكان.
ومن أهمها: توفير الأجواء لتعزيز الأمن الاجتماعي، والعلاقات الجيّدة داخل المجتمع، وتعزيز البعد الإنساني، وتقوية التآلف والروابط الاجتماعية.
ويهدف مفهوم أنسنة المدن إلى تعزيز البعد الإنساني والذوق الجمالي في بناء المدن، ويؤسس لحيوية المجتمعات واستدامتها، ويعمل على تلبية الاحتياجات الوظيفية والمعنوية للإنسان.
وقد تبنت المملكة مفهوم أنسنة المدن، وفي عام 2018م عقد مؤتمر دولي في المدينة المنورة حول هذا الموضوع.
وتشكّلت عدة هيئات ملكية وحكومية لتطوير المناطق والمدن في مختلف أنحاء المملكة.
وطرحت مبادرات متنوعة لتحقيق هذا المفهوم، تركز على عدّة مبادئ شملت:
أولًا: مراعاة «المقياس الإنساني» في عناصر التصميم والتشكيل العمراني، وما يتبعه من تهيئة للبيئة المبنية التي يعيش فيها الإنسان.
ثانيًا: «الألفة»، وما يتبعها من اتخاذ التدابير الداعمة للعلاقات الودودة بين الناس، من خلال التكوين الاجتماعي والتشكيل الفراغي للكتل والفضاءات العمرانية.
ثالثًا: «الأمان»، واتخاذ الضوابط العمرانية التي تضمن الخصوصية والراحة الإنسانية، والتحكم في حركة الآليات وتوفير نظم حركة مشاة أمنة ومريحة للإنسان، وهذه المبادئ هي بالأساس تعزّز مفاهيم جودة الحياة[3] .
دور المواطن
إنّ الاحتفال بهذا اليوم والتفاعل مع مفهوم أنسنة المدن، لا يقتصر على صنّاع القرار والمخططين، بل يشمل كلّ فرد يعيش في المدينة.
إنّ على كلّ فرد أن يهتم بمدينته كما يهتم ببيته، فمدينتك بيتك الكبير، فكّر في نظافة مدينتك، وفي جمالها وأناقتها، وفي تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أهلها، وفي الحفاظ على النظام، وحماية الذوق العام في ربوعها.
وللمبادرات المحلية المجتمعية، دور كبير في هذا السياق، مثل المشاركة في حملات التشجير، وإعادة التدوير، ودعم الأسواق المجتمعية، ونظافة وصيانة المرافق العامة.
الرؤية الدينية
وفي تعاليم الدين ما يؤكّد على الاهتمام بهذه الأبعاد الإنسانية والحضارية في المدن الإسلامية، وحين هاجر النبي  إلى المدينة المنورة وتشكّل فيها المجتمع الإسلامي الأول، صنع منها مدينة نموذجية، قياسًا إلى أوضاع ذلك العصر، وأرسى بتوجيهاته مبادئ إنسانية حضارية تستبق ما وصلت إليه الإنسانية في هذه العصور.
إلى المدينة المنورة وتشكّل فيها المجتمع الإسلامي الأول، صنع منها مدينة نموذجية، قياسًا إلى أوضاع ذلك العصر، وأرسى بتوجيهاته مبادئ إنسانية حضارية تستبق ما وصلت إليه الإنسانية في هذه العصور.
فقد أكّد  على التآلف الاجتماعي، وكان المسجد هو مكان تلاقي المسلمين يوميًا، كما أكّد على حسن الجوار ليعيش أهل كلّ مدينة كأسرة واحدة، وإن تعدّدت أعراقهم وأديانهم، ذلك لأنّ حسن الجوار لا ينحصر في أهل دينك.
على التآلف الاجتماعي، وكان المسجد هو مكان تلاقي المسلمين يوميًا، كما أكّد على حسن الجوار ليعيش أهل كلّ مدينة كأسرة واحدة، وإن تعدّدت أعراقهم وأديانهم، ذلك لأنّ حسن الجوار لا ينحصر في أهل دينك.
كما أكّد على النظافة والأناقة والجمال، فقد ورد عنه  : «النَّظَافَةُ مِن الْإِيمَانِ»[4] .
: «النَّظَافَةُ مِن الْإِيمَانِ»[4] .
وعنه  : «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»[5] .
: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»[5] .
وعنه  : «إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»[6] .
: «إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»[6] .
ونهى  عن أيّ تخريب أو تلويث في البيئة، يقول تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [سورة الأعراف، الآية: 56].
عن أيّ تخريب أو تلويث في البيئة، يقول تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [سورة الأعراف، الآية: 56].
وحثّ رسول الله  على التشجير وتوسيع المساحة الخضراء، فقد روي عنه
على التشجير وتوسيع المساحة الخضراء، فقد روي عنه  : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»[7] .
: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»[7] .
إلى كثير من التوجيهات والتعاليم الواردة في هذا السياق، التي تجعل البلد أكثر ملاءمة لإنسانية الإنسان وسعادته، وأفضل جاذبية للمواطنين والمقيمين.
إنّ نبي الله إبراهيم الخليل  دعا الله أن يجعل مكة المكرمة مدينة جاذبة للناس، يقول تعالى: ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: 37].
دعا الله أن يجعل مكة المكرمة مدينة جاذبة للناس، يقول تعالى: ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: 37].